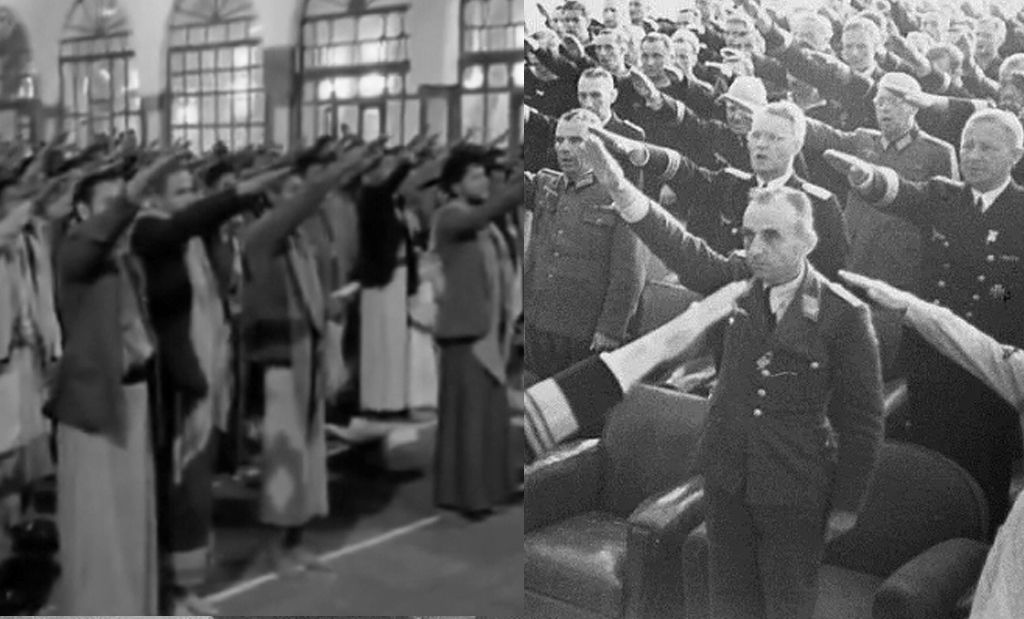في مديح الحضور

وينسىَ أن يموت
- ثمانية أعوام وما يزال عبدالله البردوني ناسياً موته. تمتصه أمواج ليله في شره صموت. تعيد ما بدأت.. وتنوي أن تفوت ولا تفوت. تثير أوجاعه، ترغمه على وجع السكوت. تقول له: مُتْ أيها الذاوي.. فينسى أن يموت. في صدره دُجى الموت وأحزان البيوت. نشيج أيتام، بلا مأوى.. بلا ماء وقوت.
- ثمانية أعوام وما يزال فيلسوفاً رائياً.. مجروحاً حتى آخر نقطة في الكأس. «نعم، لا انتهىَ شيء، ولا غيره ابتدا/ لمن أشتكي؟ لا الأهل جاءوا، ولا العدا». ثمانية أعوام وما يزال سائلاً: «لماذا يقدر الأعتى/ ويعيا المرُهف الحاني؟». ثمانية أعوام وما يزال (المواطن) عبدالله صالح البردوني داخل المكان.. والبلاد كأثر معاند ومكابر ومستحيل في مواجهة قانون الفناء وأصوله السائرة والسائدة على الكائنات.
- وكل هذا الوقت الماضي ولا أراه إلا قريباً مني. ويتعاظم هذا مع الوقت الذاهب إلى الأمام. أعماله المطبوعة في مجلدين من أيام الهيئة العامة للكتاب وحضورها، تنام الى جواري. لا أنجو من نسياني لقصيدة ما إلا إليها. وهي تنقذني من حيرتي إذا ما تناقل الاصدقاء قصيدة ما لا أعرفها، لأجدني هارباً إلى هناك. الى حيث تستريح قصائد البردوني في مجلدين نائمين الى جوار سريري.
- أتذكر جيداً آخر أمسيتين قرأ فيها عبدالله البردوني من شعره. كانت الاولى في مؤسسة العفيف بصنعاء والمناسبة احتفالية صدور كتاب لباحث سوري (وليد مشوح، اذا ما كانت ذاكرتي على صواب) قرأ البردوني بعدها من شعره. أتذكر منها قصيدة «رسالة الى صديق في قبره». وقبل أن يصل إلى نهايتها توقف منتحباً بعد «أنت في قبر وحيد واحد- وانا في قبرين، جلدي وبلادي». ليقوم أحد الحاضرين بإسعافه بقطعة حلوى؛ إذ بدا انخفاض نسبة السكر في دمه. سألناه بعدها عن من يكون هذا الصديق المعني بالرسالة، لكنه لم يجب مكتفياً بضحكته الأجمل من سماء. وكانت الأمسية الثانية قراءة في قاعة المركز الثقافي الفرنسي، وهي آخر أمسية للبردوني ولم يقرأ بعدها أبداً. في تلك الأمسية لم تستطع ذاكرته إسعافه على استحضار كامل قصيدة «كائنات الشوق الاخر» وبعد توقفه لمرات عديدة ضحك ضحكته واعداً الحضور أنه، وبعد عودته من رحلته العلاجية إلى الاردن سيذاكر قصائده بشكل جيد ولن ينسى مرة أخرى.. لكنه لم يعد إليهم.
صباح الخير يا... ناجي العلي
ما يزال ناجي العلي، بعد عشرين عاماً من رحيله (المجازي) حاضراً بما يكفي للتعليق على الأحداث وما كان فيها. ما تزال رسمته طازجة وتصلح أن تكون موجزاً لأخبار اليوم، فلسطينياً وعربياً. اكثر من صحيفة ما تزال تجد في لوحات ناجي العلي لسان حال اللحظة والحدث. لوحاته ما تزال تحتفظ بكل سخونتها. لكأنها رسُمت الآن.
ما يزال ناجي العلي، وبعد عشرين عاماً من رحيله (المجازي)، حاضراً ويشهد على الحال، حاضراً ويقول بما يحصل اليوم، حاضراً ويشير باتجاه قاتله، باتجاه رصاصة كاتم الصوت التي استقرت في دماغه. يشير باتجاه قاتله (الداخلي- الفلسطيني). لم تكن للعدو فائدة في قتله. هو كان يقصد، عبر رسمته، شيطاناً داخلياً. المنظمة، ربما! رموزها ودراويشها، ربما! أكانوا شعراء أوسياسيين أو مرتزقة موائد تونسية. كل هذا، يقول به حوض الأسيد الذي وعدوا أصابع ناجي العلي به قبل أن تنطلق رصاصة كاتم الصوت. وفي قول آخر، هو التهديد الذي، صار، واقعاً وقتلاً ورصاصة مكتومة الصوت!.
لم يستسلم ناجي العلي لأي سلطة فردية كانت أو جماعية، ولم يتح لأحد ما فرصة الضغط عليه والتحكم في مسار خطوطه على جغرافية لوحته. تلك اللوحة التي بلا ألوان. هو الأسود فقط ومتحركاً في خطوط وظلال مُشَكِّلاً ما يقوم بتشكيله. وفي هذا كان متمرداً على جغرافية حركة مضبوطة بشكل مسبق. لم يقلد أحداً او يكرر أحدا. كان ذاته كما أرادها أن تكون، ملتزماً بمهمة نبش الجراح، بقسوة متعمدة، وإعلانها للضوء في حماية للأجساد والأرواح من التعفن. كأنه، في كل هذا، كان في بحث دائم عن ذلك الضوء الموجود، ربما في آخر النفق. ولم يفقد اتصاله بالناس وبحالهم، لم يحبس ريشته في شرنقة المثقف ذي النظرة الفوقية. التحم وتضامن مع كل ما هو مقهور ومضطهد وغائب عن الصورة. ولهذا ولأسباب اخرى ما يزال حاضراً بعد عشرين عاماً من الغياب.. المجازي.. صباح الخير إذن يا... ناجي العلي.
عام على رحيل مجازي
في أيام من سبتمبر 1998 تلبستني حالة توحد مع «أهل الهوى» ولم تفارق لساني «أهل الهوى ياليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا ياليل صحبة وانا معهم». كان للمكان دوره اذ كنت في زيارتي الاولى للقاهرة، واشتبكت هذه الأغنية، من حيث لا أدري، مع رواية «حكايات حارتنا» وهي غير «أولاد حارتنا» الشهيرة، بواقعة المنع الذي تعرضت له. هذه وتلك دفعتا برغبة حارة الى عقلي وتقول بحتمية زيارة العم نجيب محفوظ في منزله الكائن بمنطقة العجوزة المعروفة بإقامة هذا الروائي الكثير فيها. وعزمت أمري. ذهبت غير عارف ولا ملم بمتطلبات تحقق هذه الزيارة.
كنت مدفوعاً فقط برغبة الاقتراب من نجيب محفوظ ومن عالمه. وصلت الى العنوان المحدد ووقفت في مواجهة المبنى الذي تحل شقة الاستاذ فيه معززة مكرمة كمعلم ومزار. لا حظت انتباه حراسة مكونة من شخصين هائلين على مدخل المبنى. اضطرني هذا الاقتراب منهم. سألتهم الدخول فكان ردهم، مؤدباً في البداية، وقالوا برفضهم إذ وتلزمني إجراءات لا بد من فعلها. أخبرتهم أن لا وقت كاف لدي في القاهرة فمغادرتي عنها وشيكة. أكدوا رفضهم ثانية. وثالثة وهنا كانت طريقتهم غير مؤدبة. وجدت ذهابي ونظرت إليه كمنقذ من موقف بدا أنه لن يكون في صالحي. عدت من ذات الطريق الذي أتيت منه ومحروماً من تحقيق رغبتي الحارة. في المساء استعدت تلك الخطوات التي قال لي بها وبضرورة التزامها حتى أتمكن من تحقيق ما أود. قمت بالاتصال بالاستاذ محمد سلماوي رئيس تحرير «الاهرام إبدو» الناطقة بالفرنسية وهو المشرف على تنظيم زيارات الاستاذ نجيب.. أخبرني بلهجة راقية أنه بإمكاني تحقيق زيارتي ولكن يوم السبت مساء حيث يجلس محفوظ عادة في «كافيه» على النيل. كان السبت صعباً كموعد إذ وسفري قبل هذا بيومين. قال سلماوي باستحالة غير هذا الموعد مؤكداً أن الاستاذ يحب اليمنيين كثيراً ويسعده لقائي. لكن السبت كان بعيداً ويقف سفري عائقاً أمام تحقيق ما وددت.
واقعة أستعيدها هنا لمناسبة عام على حضور نجيب محفوظ ثانية في هذا العالم.
jimy