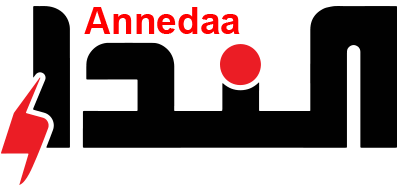مثل كل شعوب الأرض، ينسج اليمنيون لأنفسهم مجموعة من المسلّمات التي يؤمنون بها ويعتقدون أنها من الخصائص الفريدة التي تميزهم عن غيرهم. من هذه المسلّمات نجد الحكمة، التي سبق لنا أن تناولناها في مقالة سابقة، ولكن هناك مسلّمة أخرى تقترن بالحكمة وتظل تبرز في أوقات الحاجة، وهي الشجاعة. هي سمة يعتقد الكثيرون أنَّها جزء لا يتجزأ من الكينونة اليمنية، تصاحب الفرد وتظهر في المواقف الصعبة التي تتطلب اتخاذ قرارات غير تقليدية أو مواقف لا تأخذ في اعتبارها المنطق العقلي التقليدي.
في ذهن اليمني، سواء على مستوى الوعي أو اللاواعي، هناك إيمان وتصديق كامل بأنه أشجع من غيره، ويتم ترسيخ هذه الفكرة لدى الأطفال منذ الصغر، سواء في البيوت أو المدارس. ولكن، هل اليمني شجاع؟ وما هي مبررات هذا الادعاء وقرائنه في التاريخ السياسي والاجتماعي والواقع؟ وهل لهذه الفكرة علاقة بتمنطق اليمني الدائم بالسلاح، بدءًا من الخنجر (الجنبية) إلى الأسلحة الآلية الأخرى، التي قد تصل إلى الرشاشات وقاذفات (RPG)؟
لا يمكن الحديث عن الشجاعة دون وضعها في إطارها المفاهيمي والفلسفي. وهنا تتنوع تعريفات الشجاعة تبعًا للمنهج المتّبع والتخصص الذي ينتمي إليه الدارس، لكن يمكن تلخيصها بأنها الثبات عند مواجهة المخاطر، وضبط النفس في مواجهة المحن، والانتصار على الخوف، والتحلي بالجسارة ورباطة الجأش، والقدرة على التحمّل في وجه الشدائد، مع حضور الذهن واتخاذ القرارات الصائبة في المواقف العصيبة.
ولكن، أين نجد شجاعة اليمني؟ وكيف ومتى تظهر هذه الشجاعة؟
وهل يصح أن نلجأ للتاريخ لرصد وتتبع مواقف الشجاعة عند اليمنيين، أم نكتفي بقراءتها في سياقها الاجتماعي ًكصفة فردية نسبية، بعيدًا عن إطلاق الأحكام العامة؟ فالشجاع، بطبيعته، يختبر شجاعته بنفسه، وليس من خلال حياة شخص آخر، ولا يمكنه أن "يشجع" بتجانس مع آخرين دون دوافع داخلية. فالشجاعة مرتبطة بشخصية الفرد، بقصته الخاصة، وبتاريخه الذاتي.
عند النظر في التاريخ اليمني، نجد أن كفة الشجعان تتساوى مع كفة الجبناء. ففي كل حدث شهدته البلاد، كان هناك شجاع يقابله جبان أو منهزم أو خائن. وبالتالي، فإن الادعاء بأن اليمني شجاع بالمطلق لا يصمد أمام الأدلة التاريخية التي تثبت وجود الشجاعة والجبن معًا.
فعلى سبيل المثال، ذكر المؤرخ إريانوس (مؤرخ حروب الإسكندر الأكبر) أن اليمنيين كانوا الوحيدين في آسيا الذين لم يرسلوا مبعوثًا إلى الإسكندر الأكبر لتهنئته بانتصاراته على داريوس الفارسي في معركة آسوس عام 333 ق.م. كما أن الإسكندر، رغم بسط سيطرته على فارس وآسيا، لم يغامر بغزو اليمن برًّا، بل خطط لغزوها بحرًا، لكنه مات قبل تحقيق ذلك.
ولكن، أين غابت الشجاعة اليمنية عندما جاء الغزاة من الحبشة، ثم الفرس، ثم العثمانيين، والإنجليز؟ ألا يسقط منطق الشجاعة المطلقة أمام هذه الوقائع التي تثبت خضوع اليمنيين للغزاة عبر التاريخ؟ قد يقال إن الصراعات الداخلية بين اليمنيين هي التي جلبت الغزاة ومهّدت لهم الطريق. هذا صحيح، بدليل أن جذوة المقاومة ظلّت متّقدة ضد المحتلين حتى تحقق التحرير وإن كان بفوارق زمنية محيرة أيضًا، لكن الغزو وقع، ولم يكن ليحدث لولا وجود جبناء ومتواطئين من بين اليمنيين أنفسهم.
أما من منظور اجتماعي، فهل يمكن اعتبار الشجاعة إحدى سمات الشخصية اليمنية؟
الشجاعة تتضمن الحماس، والمبادرة، والمخاطرة، وقوة الشخصية والإرادة. لكن الواقع الاجتماعي يضعف مقولة أن اليمني شجاع بالمطلق، وإن كان لا ينفي أن بعض الأفراد يتصرفون بشجاعة في مواقف معينة.
في هذا السياق، يمكن الاستشهاد بأحداث 2014، عندما برزت جماعة الحوثي كتنظيم مسلح، حيث لا يمكن إنكار شجاعة أعضائها في مواجهة المخاطر المرتبطة بوجودهم السياسي والمذهبي، وكذلك لا يمكن إنكار الشجاعة المتفانية لبعض معارضيهم في مواجهتهم ومقاتلتهم.
لكن، بالخضوع للمقياس الكمي في معادلة الشجاعة -وهو متغير يفرض نفسه في دراسة أية حالة أو ظاهرة اجتماعية- مقابل الجبن في مواجهة هذه الجماعة، نجد أن كفة "الجبناء" (الخوف والتراجع) ترجح على كفة الشجعان. فعلى سبيل المثال، قبيلتا حاشد وبكيل، اللتان يُنظر إليهما كرمزين للشجاعة في سياقها القبلي، انقسمتا بين مؤيد ومعارض للحوثيين، ولم تستطيعا الصمود أمامهم. بل إن القسم المؤيد للجماعة من أبناء القبيلتين أسهم في إذلال القسم المعارض عبر تفجير منازلهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وفرض شروط مذلة على من تبقى منهم في اليمن.
وهكذا، يتضح أنَّ الشجاعة ليست سمة ثابتة، بل هي حالة مرتبطة بالأفراد وظروفهم. وبالتالي، فإن القول بأن "اليمني شجاع بالفطرة" هو قول جزئي، لا يمكن تعميمه. الشجاعة، كما نرى، ليست خاصية سائدة ولا هي سمة أساسية للهوية اليمنية. إنها لحظة من الوعي والتحدي، تظهر في ظروف معينة، وتغيب في غيرها. وعليه، يجب أن نتعامل مع الشجاعة لا كصفة ثابتة، بل كفعل معقد يتأثر بكل من البيئة والظروف الاجتماعية والقرارات الفردية.