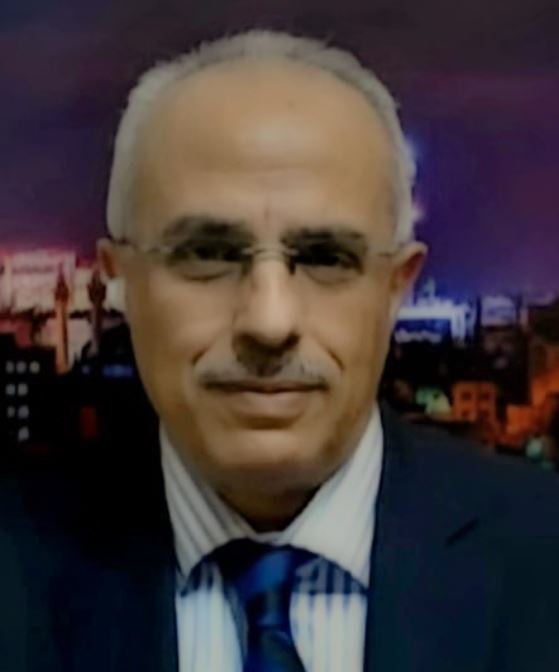لماذا اليمني مازال في حالة ضبط المصنع؟
أثناء مشاهدتي للصور والأفلام التي توثق مظاهر الحياة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، في تركيا وبلاد الشام والعراق، لفت انتباهي التشابه الكبير بين تلك المشاهد وبين ملامح الحياة في اليمن المعاصر. من أبرز أوجه هذا التشابه: لون البشرة الداكن الناتج عن التعرض المكثف للشمس، غياب الهندام في الملبس، ونحافة الأجسام.
عندما ناقشت هذا التشابه مع أحد أصدقائي اليمنيين، رد بسخرية معبرة قائلًا: "اليمنيون مازالوا في حالة الضبط المصنعي للبشر (DEFAULT)". ورغم طابع السخرية في عبارته، إلا أن فيها جزءًا من الحقيقة. إذ يمكننا ملاحظة أنه عند نقل صور لمعاناة الشعوب التي تعرضت لنكبات الحروب، كالسوريين والفلسطينيين، نجد أنهم يبدون في كثير من الأحيان أشبه باليمنيين المعاصرين. وهذا يعني أن أي مجتمع عربي يفقد مكتسبات الحضارة الحديثة، يعود إلى حالته البدائية، تمامًا كما هو الحال في اليمن.
ليس الهدف من هذا الطرح جلد الذات أو الانتقاص من هويتنا، بل هو تسليط الضوء على حقيقة يجب أن نعترف بها: نحن كيمنيين متأخرون عن ركب الحضارة البشرية. وهذا الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو تجاوز التخلف والفوضى والصراعات التي عشناها ونعيشها اليوم، والتي تنعكس في أنماط سلوكنا اليومية، وحتى في مظهرنا العام، بخاصة أثناء تناول القات.
التخلف ليس قدرًا محتومًا، ولا هو سمة جينية وراثية، بل هو حصيلة منظومة ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية قابلة للإصلاح. والدليل على ذلك أن كثيرًا من المجتمعات المجاورة لليمن كانت قبل قرن من الزمن أكثر تخلفًا، لكنها استطاعت تحقيق قفزات نوعية نحو الحداثة بفضل وجود دول مركزية قوية.
إذا دققنا النظر، نجد أن العامل الحاسم في تقدم تلك المجتمعات كان وجود دولة ذات حكم مركزي صارم، إذ أسهم ذلك في القضاء على النزاعات القبلية، وتأمين الطرق، وتهيئة بيئة مناسبة لاستثمار الموارد الاقتصادية، بما في ذلك النفط وعوائد الحج وغيرها. كما لعبت الحكومات المركزية دورًا أساسيًا في تنظيم الحياة العامة عبر فرض قوانين موحدة تشمل مختلف نواحي الحياة، بدءًا من القوانين الجنائية والمدنية، وصولًا إلى تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد.
على سبيل المثال، أصدرت السلطات السعودية مؤخرًا قائمة جديدة بأسماء يُحظر إطلاقها على المواليد، كما سبقتها قرارات تحدد الزي الرسمي للموظفات. في سلطنة عمان، تم تحديد الزي الرسمي للموظف العماني منذ زمن طويل. وفي تركيا في عهد أتاتورك فُرضت أزياء معينة ومنعت أخرى، في إطار جهودها التحديثية.
قد تبدو هذه الإجراءات من منظور الفكر الليبرالي، تعسفية، لكنها تعكس دور الدولة في تنظيم المجتمع، حتى في أدق تفاصيل الحياة اليومية.
القصد من ذكر هذه الأمثلة ليس الإشادة أو النقد، بل التأكيد على أن وجود دولة مركزية قوية هو شرط أساسي للتحديث. والتحديث المقصود هنا لا يقتصر على التطور العمراني أو التقدم التكنولوجي، بل يمتد إلى تغيير أنماط الحياة، بما في ذلك المظهر العام، السلوك، وحتى التعامل مع العادات الاجتماعية كتناول القات. فلو كانت هناك حكومة مركزية فعالة في اليمن، لما سُمح بتعاطي القات بهذه الطريقة التي تشبه السلوك الحيواني.
ومع ذلك، لا يمكن القول بأن كل نظام مركزي قادر على قيادة عملية التحديث، فهناك أنظمة تمتلك سلطة مركزية قوية، لكنها تعجز عن تحقيق التقدم، إما بسبب تبنيها أيديولوجيات متخلفة، كما هو حال طالبان والحوثيين والخمينيين، أو بسبب طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي، كما كان الحال في نظام الجبهة القومية/ الحزب الاشتراكي في جنوب اليمن سابقًا، الذي رغم نجاحه في فرض حكم مركزي صارم، إلا أنه فشل في التحديث بسبب تبنيه للاشتراكية والقيادة الجماعية التي أفرزت صراعات دموية داخل السلطة.
الدولة هي أعظم اختراع بشري، فلولاها لما نشأت الحضارات العظيمة، ولا تطورت العلوم والفنون، ولا تحقق الأمن والاستقرار والازدهار. والمفارقة المؤلمة أننا في اليمن، ومنذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، نعمل بشكل منهجي على تدمير كل مقومات الدولة. والنتيجة كانت إزالة القشرة الحضارية الرقيقة التي تشكلت خلال العقود الماضية، وإعادة اليمنيين إلى "حالة الضبط المصنعي".