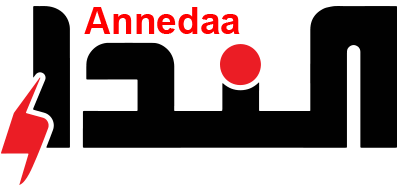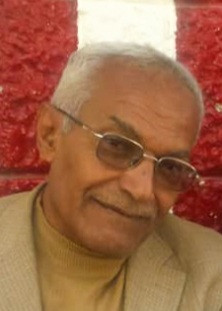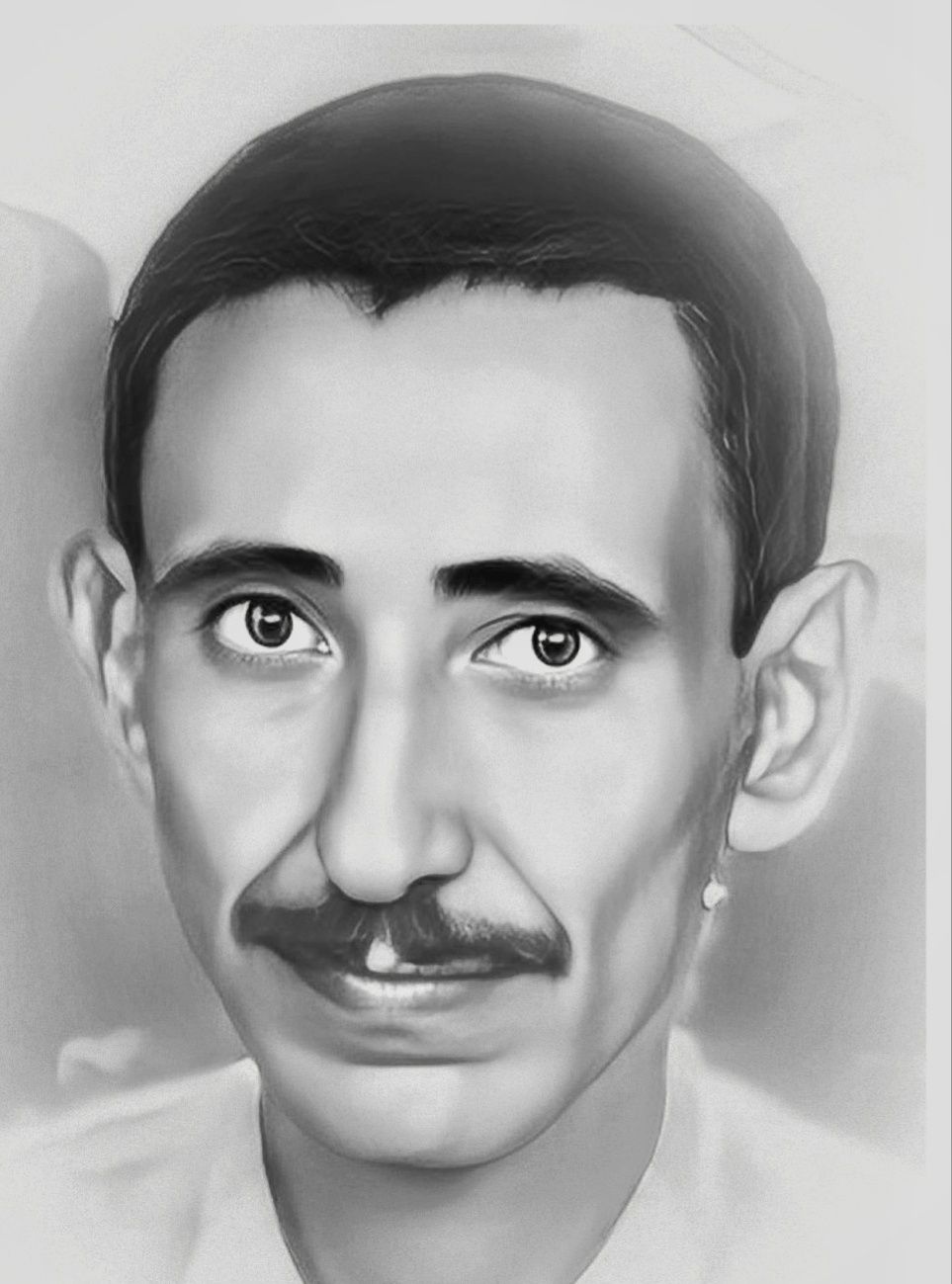أتذكر في البداية هذا الموقف الذي يعكس كيف ترسخ في الوعي العام أن المسؤولية، بلهجتها وزيها، تتبع "مركزًا" أصيلًا، وأن الجدارة بالمنصب تقتضي محاكاة هذا المركز وتمثيل امتداده.
روى لنا مثقف يمني ذات يوم أن شقيقه، الذي حصل في عهد علي عبدالله صالح على منصب محلي بسيط في إحدى المناطق المهملة والبعيدة عن العاصمة، سارع فور تسلمه المنصب إلى تبني لهجة صنعاء والزي الشعبي للقبائل المحيطة بها. وعند سؤاله عن هذا التحول المفاجئ، جاء رده كاشفًا: "ألا تلاحظون أنني أصبحت مسؤولًا؟!".
من مركزية الأمس إلى محاصصة اليوم
استمر هاجس التشبه بالمركز القديم في اليمن حتى بعد سقوطه، فالسباق المحموم على المناصب والرتب العسكرية، وإن انطلق ظاهريًا من رغبة في كسر احتكار السلطة وامتيازاتها الذي دام عقودًا، سرعان ما تحول إلى نوع من "المحاصصة الصامتة"، ولكن على نطاق أوسع من الحدود الضيقة للتنافس في المرحلة السابقة. هذه المحاصصة تتم اليوم تحت عناوين حزبية أو عبر علاقات عامة، معيارها الأساسي ولاء المرشح ومدى فائدته لمن يدفعون به إلى مواقع لم تكن في السابق ضمن أحلامه، بغض النظر عن كفاءته أو جدارته.
في المقابل، ارتفعت الأصوات المعترضة عندما اتخذت السلطة اليمنية "الشرعية" قرار تعيين شخصية محسوبة على نخبة العهد السابق، في موقع سبق أن تولاه في الماضي، هو سفير اليمن في واشنطن. لم يكن الاعتراض بالضرورة على مدى صلاحية الشخص للمهمة، بل كان رفضًا للمركز الجغرافي الذي مارس الاستحواذ في الماضي القريب، ولكل من يذكر بوجه من وجوهه التقليدية التي انتفعت من مناصبها حتى كادت أن تصبح من ثوابت النظام.
هكذا يعمل منطق التقاسم الجديد، ممزوجًا بروح انتقام من المركز السابق، يمتد ليشمل كافة القطاعات، بما فيها الرتب العسكرية والمناصب التي أصبحت تمنح تحت مبررات "ثورية" وميدانية جاهزة، في ظل معركة تتصف بالجمود والتأجيل التام لا تلوح لها نهاية في الأفق، مما يبرر استدامة استباحة المناصب وفقًا لمحاصصات غير معلنة تسخر من أي حديث عن المؤسسية وسلوك الدولة.
"الهضبة" رمز احتكار السلطة
ولعل مصطلح "الهضبة"، الذي شاع استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر عن مرارة القهر المتراكم تجاه ممارسات صنعاء ومحيطها التي احتكرت المناصب الكبرى في الجيش والأمن والخارجية لعقود. كانت هذه الدوائر "السيادية" مغلقة إلا على أصحاب الولاءات المطلقة، لدرجة أن مسؤولًا في منصب يبدو لوجستيًا داخل وزارة سيادية، كان يُعتبر أحيانًا أهم من الوزير نفسه، لأنه ينتمي للدائرة الضيقة التي ترشح الوزراء، مما يقلب الهرم الوظيفي رأسًا على عقب.
كانت منطقة سنحان، معقل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بدأت تفقد الهيمنة على مفاصل الجيش، وتصدعت أكثر مع اتجاه رأس النظام نحو توريث السلطة لنجله، مما أدى إلى انقسام داخل المركز نفسه. لكن المبالغة في اقتسام تركة النظام السابق بعد سقوطه، أوصلت خطيب جامع بسيطًا ومغمورًا إلى موقع نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلابيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، كما منحت في الشق الآخر الذي يمثل حكومة الشرعية مدرسًا لتحفيظ القرآن رتبة لواء (ركن)، بل أوصلت هذه الآلية مرشدين دينيين وأعضاء خلايا وأسرًا (إخوانية) إلى مواقع دبلوماسية لم يكونوا ليُقبلوا فيها حتى كموظفين إداريين في "خارجية زمان"، ليس تعاليًا، بل لأسباب مهنية تتعلق بطبيعة العمل الدبلوماسي وما يقتضيه من تدرج وخبرة.
وهم "التمكين الإلهي"
وبعيدًا عن تسابق الجميع لتقاسم كعكة النظام السابق والحصول على نصيب منها، سواء مع الحكومة الشرعية أو مع الانقلابيين، يعيش الإسلاميون في اليمن (سنة وشيعة) في وهم التمكين الإلهي، وهذا ليس جديدًا، فغالبًا ما يقع الإسلاميون في هذا الوهم الخطير حين يعتقدون أن آيات النصر والتمكين في القرآن وعد إلهي في خدمة مشروعهم السياسي. هذا الوهم استحوذ في فترات مختلفة ومتكررة على جماعة الإخوان، لأنهم كانوا يحصلون بالفعل في عهد علي صالح على غنائم كبرى في قطاعات التعليم والأمن والإرشاد وجمع التبرعات. وتكرر المأزق وحالة التوهم هذه المرة مع جماعة صعدة القادمة إلى المشهد من خلفية مذهبية تحصر الغنائم السلطوية في نطاق النسب الهاشمي على حساب كل القيم السياسية الحديثة التي أسقطت الثيوقراطية والعبودية المغلفة بالدين.
ويخبرنا الواقع بشواهد عملية أن هذه الجماعات المهووسة بالحكم، تضحي بمصالح الناس واستقرار مؤسسات الدولة في سبيل اختبار أوهامها الأيديولوجية وأحلام التمكين الإلهي، وها هي النتيجة تكشف عن نفسها من خلال ما يلاحظه المواطن البسيط من فشل ذريع في إدارة الشأن العام، ومن بلادة تسود كافة المؤسسات من وزارات الخدمات الأساسية إلى سفارات اليمن التي يشكو من يتعامل معها من قتامة وجوه المسؤولين وانشغالهم بالشكليات وتجاهل واجبهم تجاه الجاليات اليمنية، وما أكثر الشكاوى التي تكررت بهذا الخصوص، ولا مجال هنا للتذكير بها، وآخرها في ماليزيا.
مرحلة انتقالية صعبة
بشكل أعم يمكن القول إن بلدان ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، ومنها اليمن، تشهد إعادة صياغة آليات اختيار النخب الحاكمة، وإعادة توزيع لمراكز النفوذ الجغرافي والسياسي. فبينما كانت قرى مثل سنحان في اليمن والقرداحة في سوريا، تمثل منابع القرار سابقًا، ولها بلا شك ما يماثلها في ليبيا، تبدو الساحة الآن أوسع جغرافيًا من الناحية النظرية، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا التوسع يضمن التخلص من محسوبية ناشئة وتوازنات متفق عليها على حساب العمل المؤسسي.
نحن إذن في مرحلة انتقالية صعبة جدًا، وقد تطول، يتوقف تجاوزها على اقتناع كافة الأطراف الداخلية والخارجية بضرورة العودة إلى الاستقرار والعمل المؤسسي، مع التأكيد بأن ذلك لا يستلزم العودة للاحتكار أو الديكتاتوريات.
لكن قبل انتظار اقتناع العالم بأن استقرار دولنا يصب في مصلحته، يقع العبء الأكبر على مجتمعاتنا والنخب والهياكل السياسية والأحزاب التي تحولت إلى شبه تجمعات قبلية تبحث عن مصالحها وعن نصيبها من "مرعى السلطة"، وبسبب هذه المحاصصات الغبية والأنانية لاتزال الشعوب التي مرت بثورات الربيع واقعة بين آثار فشل الديكتاتوريات السابقة في التفريق بين السلطة والدولة، وبين فوضى ما بعد السقوط وعجز الورثة عن استعادة الدولة ومؤسساتها، وتسابقهم على استعادة "الاستقرار في الركود والهشاشة".
استجلاب الخراب
يبقى الوضع في اليمن أكثر تعقيدًا، لأنه يتجاوز التعامل مع حالة الفراغ التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق، إذ قفزت إلى الساحة قطعان ذئاب متعطشة للسلطة من كل الاتجاهات، أخطرها جماعة صعدة، وهي الطرف الذي تسبب في جلب أكثر من لون من ألوان التدخل الأجنبي، آخرها التدخل العسكري الجوي الأمريكي، والأدهى من ذلك أن الطرف الذي جلب العدوان سعيد بجحيمه، ويتمنى أن يطول أمده ليحتمي وراء المظلومية الزائفة.
وكما يقال فإن العبرة بالخواتيم، لأن النتيجة تثبت منذ الآن أن من يرفع الشعارات ضد العدوان هو الذي فتح له الأبواب ومهد له الطريق واستعجل الخراب. ومن لا يجيد السياسة أو يتهرب من حلولها، ويكتفي بامتهان الحرب، لن يفلح إلا في توسيع الحفرة تحت قدميه، وزيادة الخراب، واستجلاب المزيد من طائرات الأغراب.
القصة تتكرر في سوريا
الديناميكيات المتعلقة بتقاسم تركة النظام السابق من المناصب والمواقع والغنائم، تجد صداها في سوريا الجديدة، فبعد سقوط نظام الأسد ودخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، أشار البعض إلى أن سكان العاصمة بدأوا أخيرًا يتعرفون على التنوع الحقيقي لإخوتهم السوريين القادمين من محافظات مختلفة، بلهجاتهم ووجوههم وبيئاتهم المتنوعة. كان ذلك دليلًا على أن النظام السابق صبغ المشهد الرسمي بلون واحد، فارضًا لهجته ونموذجه.
ومع أن التشكيل الحكومي الأخير في سوريا أظهر وجوهًا جديدة من خلفيات متنوعة جغرافيًا، برزت في الصف الأول، وبعيدًا عن الخلفية الفصائلية للوزراء، والتي تلغي التنوع، وتجعل منه كذبة، برز السؤال الجوهري: هل يعكس التنوع الظاهري للوجوه توزيعًا للنفوذ، وكسرًا للمركزية السابقة، وبداية لتمثيل أوسع يعتمد على الأهلية والاستحقاق؟ أم أن ضبط أطماع القادمين الجدد إلى السلطة كان المعيار الذي تطلب انتهاج مبدأ "الإرضاء" عبر المحاصصة، مما قد يؤجل بناء الدولة المؤسسية الرشيدة التي تحتاجها سوريا بعد سنوات الفوضى؟