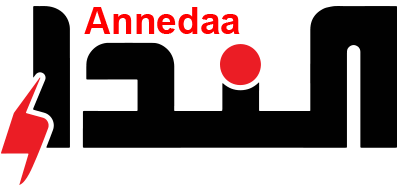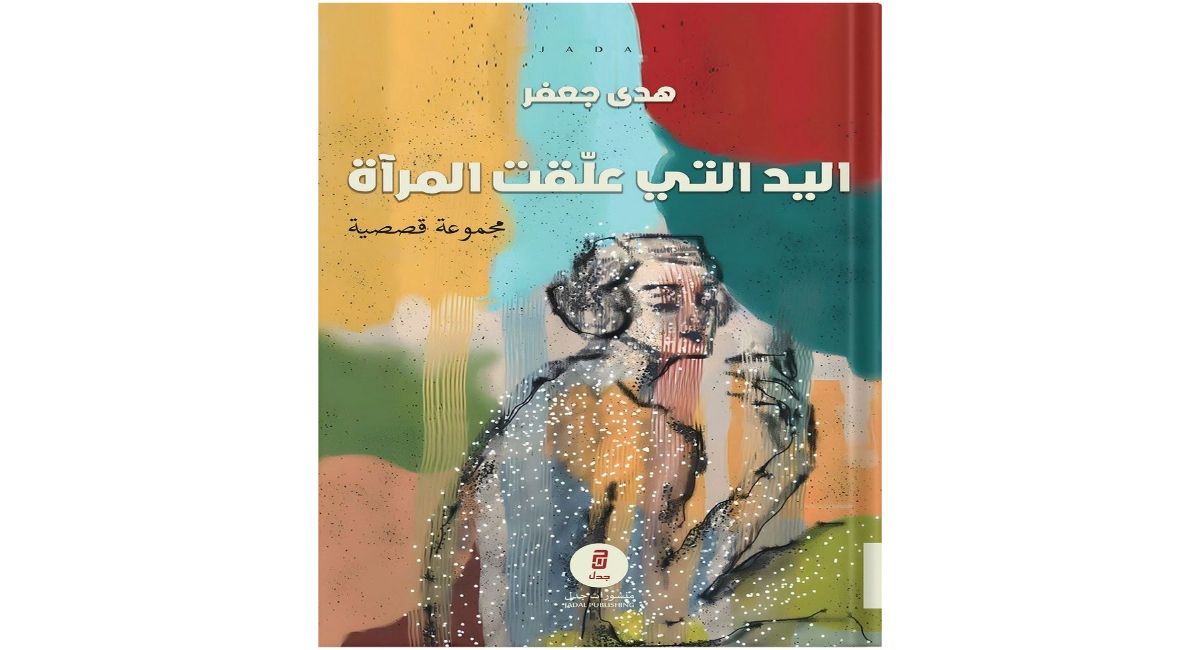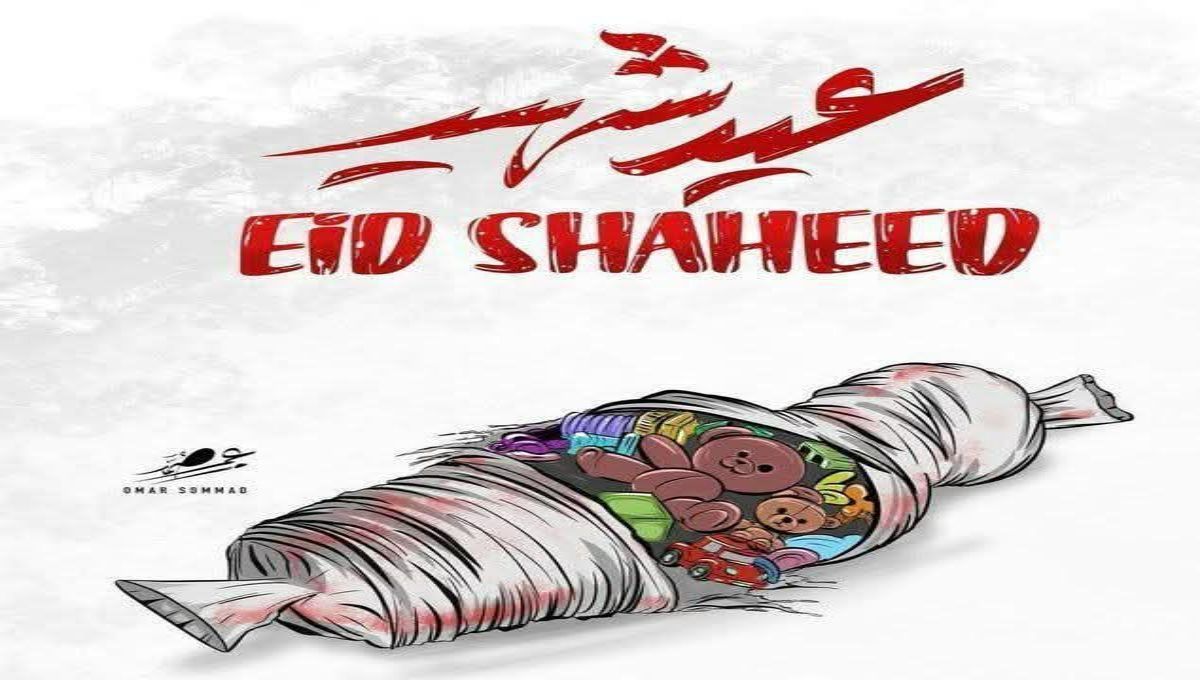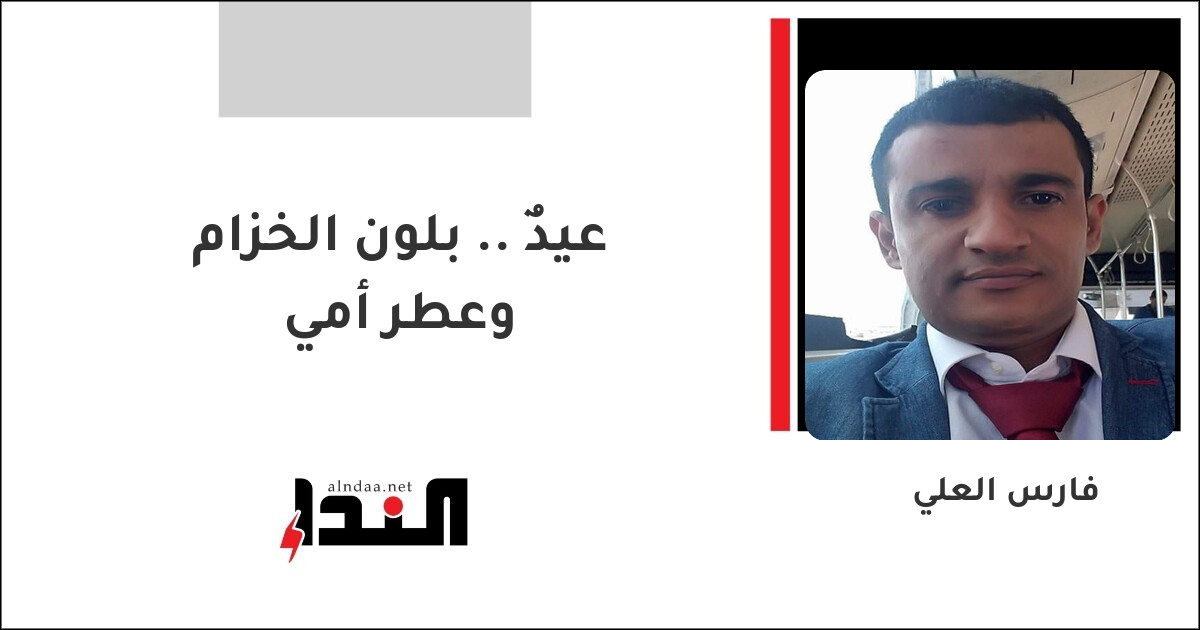«اليد التي علقت المرآة» سبع قصص قصيرة تحتل مساحة 132 صفحة من القطع الصغير، وتبدأ بمقولة: "تذكرة تلك السيدة التي قالت لنا: إنَّ الأطفال يعيشون حتى بلوغهم في عالم غير مرئي يُدعَى «مرقص القرد»".
ويبدو أنَّ القاصة هدى جعفر قد جعلت من هذه «الحكاية» بابًا أو مفتاحًا سحريًا؛ للولوج إلى قراءة قصتها، وربما جانبًا من حياتها.
«في الباب وأنا وعنايات أبو سِنَّة» (بطلة مسرحية) القصة الأولى في المجموعة، تتحول الدُّميَة إلى طفلة وصديقة حميمة، أو ظلٍّ لها. تقرأ أسرارها، وتتنبأ بمستقبلها (الباب).
وأروع ما فيها الرؤى المنامية. فالرؤيا سرد داخل السرد، وخيال داخل الخيال، وعلاقة المنام بالنبوءة والإبداع وقراءة كف المستقبل عميقة وواسعة.
اللغة حديثة، والوصف غاية في الدقة والتصوير؛ تندغم الدُّمية بهدى كصاحبة تُسمِّيهَا «عنايات أبو سنة» (البطلة المسرحية التي لهدى قصة معها).
تُقدِّم لطفولتها ولقصة امتلاكها للدمية القطنية التي تماثلها طولًا، وتصف علاقتها بالخيال وحظها من الذكاء، وعلاقتها بالنوم وشياطينه في حكايا الكبار، وخيالها الواسع كالقفار في سرد الجدات.
تقدم وصفًا لصديقتها، ولأناقة ملابسها، وكُحْل عينيها. يتسارران كأتراب. وفي حين رأتها ابنة الجيران (التي أرادت اللعب بها) مرميةً بعيدًا، كانت هدى تراها شاخصة نحو السماء.
المفارقة أنَّ هدى بعد ليالٍ طويلة رأت الدمية «عنايات» مرميةً، تتبول عليها القطط، وتتمشى عليها أسراب النحل. اقتربت مِنْ هدى هامسة: "لو لم تكوني الباب، لما خرجت منك الدُّميَة".
«عنايات» (الدمية) تؤكد صدق نبوءتها، وتدلل على طبيعة «الباب» ومعناه. ولعلَّ قصة الخادمة التي جاءت بعد عشرين عامًا لتعمل وتنام في غرفة هدى (تركت العمل بعد يومين؛ لأنها ترى في المنام امرأةً طويلة بملابس خضراء تخرج من جوفها)؛ تعبير عن طفولة هدى و«عنايات» التي لا تزال تملك نفسها.
ربما لا تقبل «عنايات» مَنْ يحتل مكانها؛ فهي حتى بعد عشرين عامًا لاتزال تملأ نَفْس هدى، وتنام على صدرها.
بنت الجيران ذات الضفائر والأسنان التي أرادت اللعب مع هدى بالدُّميَة، رأتها هدى مع عشرات الدمى؛ فسألتها عن الدمية، فأنكرت وجودها، وقالت: "أنا أنت، وأنت أنا".
وتتجلى موهبتها الإبداعية في «نصف بصلة»؛ حيث تجعل من نصف بصلة أخوين بطلين يتبادلان الكره والموهبة والسمات. يتحول النجار إلى شاعر، والشاعر إلى نجار، والرجل إلى امرأة.
القصة تَنمُّ عن موهبة ومقدرة وذكاء مدهش في توزيع الأدوار وتحديد المصائر. فـ«العقربان الأسودان» -أحدهما فوق ظهر الآخر- هما بطلا القصة، وهما النجار والشاعر؛ أي شخص واحد يتبادل الأدوار.
أحدهما يعبئ البيوت بجثث مصقولة متيبسة، ويقلبها أخوه على رأسها فتفرغ ما بداخلها شيئًا فاتنًا قاهرًا اسمه «الشعر».
سردية اللعب بألواح الخشب لصنع قارب، وإيعاز أخيه للجذوع، ورد أخيه بالتحول إلى امرأة وشاعرة في آنٍ، تُظهر ساردة موهوبة ماهرة.

قصتها حَدِيثٌ عن الجنس، واختراق عامد للتابو، فيه شجاعة نادرة، وخيال خصب، وجرأة نفتقر إليها، كما في قراءة «العمليات الحربية» التي تخدش الحياء.
أدبنا العربي القديم والوسيط زاخر بهذا اللون من البوح، ولعلَّ الجاحظ كان أول من دوَّن في رسائله. وكتابه المفقود «العرس والعرائس»، وما دونه في «الحيوان» من نماذج للممارسة مع الكلاب بإجراء مقابلات معهم! وكتب «الأغاني»، للأصفهاني، و«الغصن الرطيب»، للتلمساني، و«نهاية الأرب»، للنويري، وعشرات الموسوعات الأدبية الأخرى.
ولعلَّ أهم موسوعة هي «رشد اللبيب في مسامرة الحبيب»، لواحد من أهم مؤسسي الغناء الحميني اليمني؛ كاتب الدولة الرسولية ابن فليتة الحكمي، و«الأغاني»، و«العقد الفريد»، لابن عبد ربه.
وصَنَّفَ القاضيان التونسيان كتابيهما المهمين: «الروض العاطر»، و«تحفة الألباب»، كما صنف العلامة جلال الدين السيوطي عشرات المؤلفات في هذا الباب؛ ولعلَّ أهمها: «رشف الزلال»، و«نواظر الأيك»، و«رقائق الأتْرُّج في شقائق الغنج»، وكتب الفقه الكبيرة لا تخلو من الطرائف، خصوصًا في أبواب: الوضوء، والغُسْل، والزواج.
ولكي تعطي الساردة للقصة رائحة الواقع؛ فقد حددت الأماكن والمناطق بدقة في الأوصاف.
«لحظة كوداك عند لعبة الأحصنة الدوارة»، وهي قصة رئيسية في المجموعة تمثل مزيجًا من الوصف الصحفي الدقيق، والمتابعة، وحكايات المشاهدات العينية، وقراءة لمدينة الملاهي «هولا بارك» التي عملت فيها، وقدمت وصفًا دقيقًا لكل ما فيه من ألعاب وحيوانات وزوار.
وهي ليست حكاية واحدة، بل مجموعة حكايات مسرودة بمهارة ودقة ولغة رفيعة. تبدأ بسرد قِصَّة السيدة التي كسرت أنفها. ووصفها لمدينة الملاهي ينتقل بين السرد القصصي، والتحقيق الصحفي.
قصة «شعرة في صحن العالم». فالطفل «علي» القادم من إحدى قرى تعز، يفقد أمه «ناعمة» (عمرها 15 عامًا)، وهي تحمل الحطب فوق رأسها كحال آلاف القرويات في جبال الحجرية، وإب، وبرع، وريمة، وذمار، و«مناطق المرأة»؛ كما يسميها الهمداني في «الصفة».
القُرَى المعلقة في السماء، يدخلها السحاب طول اليوم؛ كما تصف القاصة. ويفقد «علي» أباه الذي لحق بأمه بنفس الطريقة (الوقوع في الهاوية).
يغادر الطفل «علي» إلى عدن بعد العجز عن مواصلة التعليم التقليدي بسبب الفقر. في عدن، يعمل أولًا عامل نظافة في الميناء، ثُمَّ لدى «طافية»؛ الخبيرة في طبخ الزربيان، والابنة التي قذفتها أمها الهاربة من النار، فالتقطها صالح باعباد، وسلمها للجيران قبل أن يهاجر إلى كينيا.
سُميت بـ«طافية»؛ لأنها نجت من النار. تزوجت مرتين: الأول: تاجر قماش تُوفيَ غرقًا، والثاني: تاجر قماش ثرثار طلقته سريعًا، لتصبح أشهر طباخة زربيان في عدن.
يتدرج «علي» في العمل من تقطيع البصل والبطاط، وإحضار الحاجيات من الدكاكين، إلى المساعدة، وتلقي نصائح «طافية» فيما يتعلق بطقوس الطبخ.
تعطي «طافية» للطِّبَاخة معنى العبادة، ولديها مواعظ كثيرة: "أسوأ طبَّاخ هو من يُوجَد في طبخهِ شعرة واحدة".
وتنصحه بعدم البكاء أثناء الطهي، وبتغطية شعره جيدًا. للطاهي عندها صفات إلهية: «يحيي ويميت».
يتناول النص بداية الثورة، وتقاسم الثوار والإنجليز شوارع عدن، بينما بقيت عدن موحدة في مطبخ «طافية».
فجأةً تموت «طافية»، ويُغلق المطبخ لأشهر. ويصف «علي» تراجع دوره، وتدفق الاشتراكيين على عدن، وندرة الحاجيات، وفرار العدنيين إلى شمال اليمن ثم إلى بلدان أخرى.
يرتب «علي» للهرب بعد أن وجد صديقه «سعيد حمادي» مقتولًا، ويرسم صُورةً قاتمةً لاستيلاء المليشيات على البيوت، وتهجير الملَّاك.
الصور التي يرسمها لعدن لا تقل رعبًا عن صورة صنعاء في قصيدة عبدالله عامر «دُشْمَان دخل بالجلافة»، لكنَّ الفارق أنَّ عدن كانت تشهد انتصار حركة التحرر الوطني، بينما كانت صنعاء تواجه انتكاسة الثورة الدستورية (أول ثورة دستورية في المنطقة).
القاصَّة تؤرخ لدور عدن في احتضان الوافدين من الشمال (خصوصًا ريف تعز)، وتقارن بين قسوة الحياة في الريف المتخلف وازدهار عدن.
بمهارة وذكاء ترسم النهاية البائسة لمطبخ الزربيان (أرقى وجبات الأعراس في عدن)، وحياة «أبو ياسمين» (الشعرة في صحن العالم).
في «غازي مع حبي» تحكي حياة أسرتها الصغيرة، وكراهية أبيها لتربية الحيوانات (مخافة العقاب الإلهي)؛ بينما هي وإخوتها يرغبون بتربية الكائنات: الحمام، القطط، الدجاج، السمك، والسلاحف.
«غازي» (السلحفاة) هو بطل القصة الذي دهسته سيارة، وبقي حضوره في ذاكرتها حيًا لأعوام. تحكي كيف كانوا يتحايلون على أبيهم بإدخال الحيوانات خِفْيَة، ويفشلون في الاحتفاظ بها.
«صلاة مسعود» هي الأكثر غرائبيةً وإدهاشًا. تبدأ في ديوان عاقل الحارة «سعيد شايف» بالاستماع لـ«صلاح» (سائق الدراجة) الذي يحكي قصة «مسعود» في السادسة والربع من يوم الأربعاء. وبينما كان يضحك، شَعرَ بألم مفاجئ في جبينه؛ فظهرت نقطة بُنِّية صغيرة تحولت إلى حَلَمَة أنثى، ثُمَّ إلى ضرع يسكب الحليب! أرضعَ مولودةً في الحافة، ونصحه الشيخ «طه مقبل» (إمام المسجد) بسترها؛ لأنها «عورة»، وأعطاه قماشًا للحجاب.
زوجته «مريم» وجدت أشياء كثيرة قد بيعت للتداوي. اعتزل في منزله، ثُمّ تحول إلى «فُرْجَة» للتصوير بنصيحة أصدقائه، واقتسموا العائد. واقتنع أخيرًا أنَّ حلمته ذكورية، فاستعاد نشاطه.
تمزج القصة بين غرائبية ما حدث، وتزاحم الجن لمشاهدة «معجزة» مسعود في منام، وتتحول الحلمة من ثدي للرضع إلى إغراء لمجنون ينقض عليه.
يختفي مسعود، ويحلَّ الحديث عن اختفائه مَحلَّ الحديث عن الحلمة.
القاصَّة هدى جعفر بخيالها الخصب، ومقدرتها المدهشة على نسج الحكايات، ولغتها الراقية، واحتفائها بالتفاصيل، وبراعتها في التصوير الدقيق للمكان والزمان، والنَّفَس الطويل في السرد، يؤهلها لتكون روائية ينتظرها مستقبلٌ باهر، كنبوءة «عنايات».