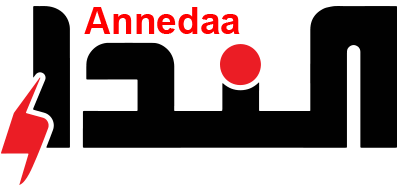بادئ ذي بدء أقول: يعتبر الإنسان أقدر الكائنات الحية على التكيف والتأقلم مع محيطه البيئي الذي يعيش فيه... إلخ.
وبغض النظر عن ماهية ذلك التكيف والتأقلم وأسبابه والظروف التي تستدعيه... إلخ، وكذلك إيجابيته أو سلبيته، مطلقًا أو نسبيًا... إلخ، إلا أن هناك حدودًا يجب ألا يتم تجاوزها أثناء عملية التكيف والتأقلم من قبل الإنسان مهما كانت الظروف التي تستدعي ذلك من الصعوبة بمكان وزمان... إلخ.
فمثلًا، لا يجوز القبول بالعبودية وتقبلها والرضا عنها بداعي التكيف والتأقلم مهما كانت الأساليب والوسائل والطرق المتبعة في سبيل فرضها وتجذيرها، ومهما كانت التضحيات في سبيل التخلص والتحرر منها، لأن ذلك القبول والتقبل والرضا بداعي التكيف والتأقلم، وبداعي عدم القدرة والمقدرة على التخلص والتحرر منها، وبداعي ترك مسؤولية ذلك لأناس آخرين، وليست مسؤولية فردية على كل فرد.. فإن تلك العبودية، ومع مرور الوقت، وفي ظل عدم مقاومة لها في بداياتها، سوف تتشعب وتتجذر، وقد تصل إلى أن تكون عبودية طوعية أو مختارة، وفي هذه الحالة فإن عملية التخلص والتحرر منها بعد طول زمن تكون صعبة للغاية، وإذا حدث ذلك تكون تكلفتها باهظة الثمن على الإنسان الفرد والإنسان المجتمع... إلخ.
إن القدرة والمقدرة على رفض العبودية ومحاولة التخلص والتحرر منها لا تتوفر لدى كل إنسان، إنما لدى الخاصة منهم (النخبة)، وهي مسؤوليتها بالدرجة الأولى والأساسية، لكن ذلك لا يعفي العامة من المشاركة والمساهمة في ذلك حتى ولو بالدعم المعنوي لتلك الخاصة.
إن من يتكيف ويتأقلم من العامة ومن الخاصة بخاصة مع العبودية، ولا يقوم بأية ردة فعل حيالها حتى ولو بأضعف الإيمان، فإنما يعتبر مشاركًا ومساهمًا في تجذيرها.
وهنا يكون التكيف والتأقلم في أقصى درجته السلبية وأشدها وأفظعها وأقبحها.
فالإنسان الرزين والحكيم عمومًا هو الذي يستطيع معرفة متى يتكيف ويتأقلم، ومتى يتوقف عن ذلك.
فليس، ووفقًا للظروف المحيطة، كل تكيف وتأقلم إيجابي أو سلبي، بل قد يكون سلبيًا أو إيجابيًا، إذ إن هنالك فرقًا كبيرًا بين الانبطاح والخضوع والرضوخ التام بداعي التكيف والتأقلم، وبين التكيف والتأقلم بغرض إعادة التقييم (استراحة محارب)، ومن ثم النهوض والانطلاقة مجددًا.
فعملية الانحناء للعاصفة بغرض التكيف والتأقلم إذا استمرت لفترة طويلة، تسبب تصلبًا بالعضلات والعظام، ولا يستطيع الإنسان بعدها النهوض ومن ثم العودة إلى الاستقامة مجددًا مهما فعل أو حاول، وذلك لن يؤدي أخيرًا إلا إلى الانبطاح والدعس والدهس... إلخ.
يقول دارون: ليس أقوى أفراد النوع هو الذي يبقى، ولا أكثرهم ذكاء، بل أقدرهم على التأقلم مع التغيرات.
ويقول ألفونس دو لامارتين: الناجح لا يشتكي من الظروف، بل يفكر في تغييرها أو التأقلم معها.
هذا من ناحية التكيف والتأقلم، أما من حيث التربية، فإن بيئة الحرية لا يمكن لها إلا أن تنتج أحرارًا، عامة وخاصة، مثقفين وغير مثقفين، حكامًا ومحكومين، سلطة ومعارضة، مبدعين ومتألقين... إلخ.
وعلى العكس منها، فإن بيئة الاستبداد والعبودية لا يمكن لها، غالبًا، إلا أن تنتج مستبِدين (بكسر الباء) ومستبِدين (بفتح الباء)، سادة وعبيدًا، رعايا ورعاعًا وأقنانًا.. لا مواطنين ولا مبدعين ولا متألقين... إلخ.
فمن تربى في الهواء الطلق والمجال الفسيح لبيئة الحرية، لا يمكن له أن يقبل بتضييق ذلك والعيش في بيئة أخرى غير بيئته تلك، وإذا أجبر على ذلك فإنما لفترة محدودة يعمل خلالها على التخلص والتحرر من تلك الظروف التي أجبرته على ذلك.
وعلى العكس من ذلك تمامًا، فمن تربى في الغرف المغلقة المظلمة والكالحة، وتشكل وعيه وشكل في تلك الغرف، لا يمكن له أن يشعر ويحس بأهمية وبقيمة الضوء، أو يتقبل فجأة شعاعه الساطع، أو حتى مجرد التكيف والتأقلم معه متى ما بزغ ذلك الضوء ولاح في الأفق، وسطع نوره في جميع الأرجاء وفي كل الاتجاهات، بل إن ذلك قد يسبب لدى البعض عاهة مستديمة.
ومع ذلك، وبرغم كل ذلك، فإن للنور بريقًا لا يضاهى، وتأثيرًا سحريًا لا يقاوم، حتى عند أولئك الذين تعودوا على العيش في الظلام، متى ما استطعنا إيصاله إليهم.
الخلاصة
لقد خلقنا الله أحرارًا، وولدتنا أمهاتنا أحرارً،ا لكننا أبينا تلك الحرية بقصد أو بدونه. بمعنى أن طبيعتنا نحن البشر طبيعة حرة وليست عبودية.
ففي كتابه القيم "مقالة في العبودية المختارة"، وأمام وإزاء ما شاهده إيتيان دو لابوسيه من تفشي وتجذر ظاهرة العبودية المختارة في أوساط الناس، عامة وخاصة، يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث يتساءل: "ولكن ما هذا يا ربي؟ كيف نسمي ذلك؟ أي تعس هذا؟ أية رذيلة، أو بالأصدق، أية رذيلة تعسة أن نرى عددًا لا حصر له من الناس لا أقول يطيعون بل يخدمون، ولا أقول يحكمون بل يستبد بهم!".
فهم لا يملكون في حياتهم ومن حياتهم شيئًا، فكل حياتهم مسخرة للطاغية وملك وملكية خاصة له، ولا يملكون جراء ومقابل ذلك سوى البؤس والفاقة والحرمان والتعاسة... إلخ، ومع هذا نجدهم خانعين مستسلمين له، ليس الواحد منهم، بل بمئات الآلاف وبالملايين، وهو (الطاغية) لوحده، ولا يحركون ساكنًا في سبيل التحرر والتخلص والخلاص منه. "فأنى لنا باسم نسمي به ذلك؟ أهذا جبن؟"، هكذا يتساءل، ثم يجيب بدهشة وحرقة شديدة: "إن لكل رذيلة حدًا تأبى طبيعتها تجاوزه، فلقد يخشى اثنان واحدًا، ولقد يخشاه عشرة، فأما ألف، فأما مليون، فأما ألف مدينة إن هي لم تنهض دفاعًا عن نفسها في وجه واحد، فما هذا بجبن، لأن الجبن لا يذهب إلى هذا المدى، كما أن الشجاعة لا تعني أن يتسلق امرؤ وحده حصنًا أو أن يهاجم جيشًا أو يغزو مملكة! فأي مسخ من مسوخ الرذيلة هذا الذي لا يستحق حتى اسم الجبن، ولا يجد كلمة تكفي قبحه، والذي تنكر الطبيعة صنعه، وتأبى اللغة تسميته؟".
إنه هنا يشير وبعمق إلى سيكولوجية العبودية المختارة، تلك العبودية التي لا تقتصر فقط على عبودية الأجساد، بل تتعدى إلى أن تشمل عبودية الأرواح والأنفس، لتصير عبودية جسدية روحية نفسية، إذ إنه وفي مجتمع العبيد والعبودية النفسية والجسدية (العبودية الطوعية)، تصبح وتصير تلك العبودية هي الفضيلة! والحرية هي الرذيلة!
يصبح ويصير الحر فيه شاذًا، مذنبًا ومدانًا ومنبوذًا، محاربًا ومطرودًا، بل قد تسلب منه حياته نتيجة ذلك الفعل الشنيع الذي ارتكبه! ليس من قبل الأسياد في ذلك المجتمع العبودي، بل من قبل العبيد فيه، وبمطالبة ومباركة منهم.
لكن الأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي:
كيف لأولئك الطغاة أن يصيروا طغاة؟ وكيف تسنى لتلك العبودية أن تصير عبودية مختارة؟ وما هي الأساليب والعوامل المختلفة التي ساعدت على ذلك وتلك..؟
بمعنى، وبحسب ما ورد في مقالته تلك: "كيف استطاعت جذور الإرادة العنيدة، إرادة العبودية، إلى هذا المدى البعيد، حتى صارت الحرية نفسها تبدو اليوم كأنها شيء لا يمت إلى الطبيعة بسبب؟"، وبخاصة، وكما يرى "لا نولد أحرارًا وحسب، بل نحن أيضًا مفطورون على محبة الذود عنها".