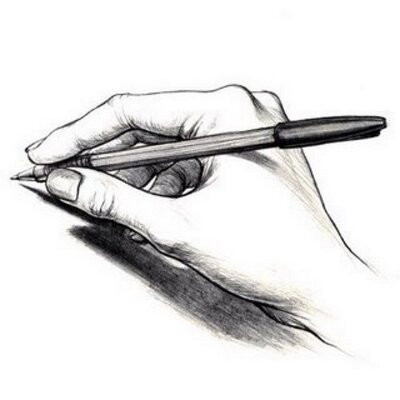عندما قرأت منشور الأستاذ سامي غالب، الدامي، لنبش قضية "الاختفاء القسري"، وجاء على ذكر صالح السييلي وأفراد من أسرة الراحل شعفل عمر وغيرهم، عادت بي ذاكرتي المتعبة إلى ملف "النداء" حول ذات الموضوع، وقد أشرت في منشور قصير إلى أني مازلت أحتفظ ببعض مواد صحيفة "النداء".
عند نبش ما تبقى من أوراق وجدت فعلًا مجموعة لا بأس بها من المادة المنشورة في أعداد "النداء"، ابتداء من 16 مايو 2007 وحتى 19 سبتمبر 2007. إضافة إلى ورقة ("النداء الاختفاء القسري": "الحياد المستحيل")، المقدمة من الأستاذ نبيل لمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، والتي تناولت المسألة من جانبها الإنساني والأخلاقي، والمسؤولية التي تقع على المجتمع ومنظماته في إماطة الحجاب المسدول على هذه القضية وضحاياها، إلى جانب ورقة محمد المقطري المحامي، حول نفس الموضوع، ولكن من وجهة نظر القانون اليمني، حيث طهر البون الشاسع الفاصل بين غايات القانون في الواقع، وغايات الساسة. وإلى جانب أن الملف الذي أحتفظ به يحوي مادة دسمة جدًا ولافتة للانتباه، فهو قد وضع النظام والمجتمع حينها في مكاشفة لإجلاء حقيقة وضع "المخفيين".
ومن بين موضوعات تلك المادة، تبرز مقابلة مع علي تيسير، وكيل وزارة حقوق الإنسان، أجراها الزميل جلال الشرعبي. ما استرعى انتباهي في المقابلة، أن الوكيل قد أبلى حسنًا في دفاعه عن النظام الذي يمثله، إلى حد أنه لم يجد فارقًا يميز بين الحكومة التي ينتمي إليها كأفراد أو تنظيمات تمثل مصالح متشابكة، وبين الدولة كمؤسسة. فمثلًا، يقول تيسير عن مسؤولية الدولة عن الاختفاء القسري: "كيف أحاسب أشخاصًا ليس لديهم يد في الموضوع، ولم تكن الدولة الحالية هي من تحكم! والمسؤولون ليسوا هم أنفسهم عندما حدثت عملية الاختفاء! ولو كانت الدولة هي التي تحكم لحاسبناها بشكل كبير!".
أترك هذه الفقرة للقراء لتحليلها بتناقضاتها وعلاتها. الوكيل يعتبر الدولة غير مسؤولة عن اختفاء الناس، ولكن إذا لم تكن الدولة باعتبارها مؤسسة مسؤولة لعدم توفرها، فإن السلطة الحاكمة هي المسؤولة مباشرة عن تنفيذ القوانين التي تسنها وتتباهى بها أمام المجتمع الدولي لنيل رضاه. ومع أن مناقشة وتحليل العبارة لم يعد ذا معنى الآن، إلا أنه يعطينا صورة واضحة للكيفية التي يتعامل بها رجل السلطة مع قضية بهذا الحجم والأهمية، وهي بالضرورة كيفية مختلفة عن كيفية رجل الدولة. كما أن العبارة عند إسقاطها على واقع اليوم ينعدم الفارق الجوهري الذي يمكن أن يميز طرفًا عن آخر. فمازال المخفي قسرًا وأهله في موقع المتهم، وليس المجني عليه. مازلت لا أفهم كيف يمكن للضحية الاحتكام للجهة التي تمثل الخصم في واقع "الاخفاء".
يرتكز مفهوم الاختفاء القسري على ثلاثة عناصر متراكمة (حدّدها التقرير الذي أعده الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري عام 2010)، وهي:
"الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛ وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛ ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده."
ويؤكد ذات التقرير أن "للاختفاء تأثيرًا سلبيًا مضاعفًا يَشلّ كلًا من الضحية المحرومة من حماية القانون، والتي غالبًا ما تتعرض للتعذيب، وتبقى في خوف دائم على حياتها، والأسر التي تجهل مصير أحبائها المختفين، وتتأرجح مشاعرها بين الأمل واليأس، وتبقى في تساؤل مستمرّ وانتظار دائم، مدّة سنوات طويلة أحيانًا، لسماع خبر قد لا تأتي أبدًا."
ويضيف أنه "غالبًا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات. ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل يؤثر أيضًا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل."
من جهتي، لا أميل كثير لاستخدام عبارة "الاختفاء القسري"، بل أفضل استخدام عبارة "الإخفاء القسري" عوضًا عن ذلك، لتوفر القصدية فيه من قبل الطرف المهتم بتغييب هذا أو ذاك من الأشخاص.
لكن الملاحظ أنه خلال تلك الفترة التالية لحملة "النداء"، زاد ملف "الإخفاء القسري" تضخمًا، وكثرت الأطراف التي يمكن أن تقوم بعمليات الإخفاء، حتى إننا سنجد صعوبة في تحديد الطرف المعني الأكيد بها... كل الأطراف لديها دوافعها الكثيرة للقيام بذلك، بعض تلك الدوافع يمكن استقاؤها من تاريخ العمل السياسي السري، وبعضها من طرائق العمليات الأمنية المباشرة، والبعض الآخر قد يكون من منتجات الصراع الحالي.
باندلاع ثورة الشباب السلمية تشكلت عند الناس آمال عريضة بخصوص حل ملف الإخفاء القسري حلًا سياسيًا وإنسانيًا عادلًا يقوم على معرفة مصير المخفيين دون استثناء أولًا، ثم معرفة أسباب الإخفاء والجهات والأشخاص المتورطين بعمليات الإخفاء، وعلاقة ذلك بالقانون والدستور والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق والحريات وجرائم الإخفاء.
كنا ننتظر مثلًا أن تبادر الأجهزة والأشخاص الذين أداروها أو حتى عملوا فيها، إلى كشف أسرار هذا الملف طوعيًا. وكنا نراهن على الجدران التي احتضنت وجوه المخفيين قسرًا، بتذكير هؤلاء بالمسؤولية الأخلاقية. يبد أن البعض فعلًا قد تذكر وجوهًا مرت أمامه فسارع لإخفائها مجددًا، ولكن من الجدران هذه المرة. لقد ظلت الجدران أمينة لتلك الوجوه، وظل المسؤولون عن الإخفاء أمناء لماضيهم. دائمًا ما تنشق الشوارع وتقذف من أحشائها بوجوه شاحبة لأناس ابتلعتهم السراديب دهورًا، وقد رسم الزمن على تجاعيدها تاريخًا من العذاب والقهر، في كل زقاق مظلم حتمًا ستجد إنسانًا محطمًا قُذف فجأة في مواجهتك كأنه حط من السماء. هكذا كان حال المهندس أحمد السروري بعد رحلة طويلة من الإخفاء، والإرياني تكشفت لأهله حقيقة فقدانه من أعماق إحدى المصحات، قد لا تعرف من أين سيبرز أمامك شبح إنسان، لكننا نتمنى في كل حين أن تنشق كل السراديب وتحدث أخبارها.
مع الوقت يتلبس الإخفاء ثوب البطولة المتشح بالأسطورة، ويصير حكايات الأمهات لأطفالهن قبل النوم وعند السؤال. لا تصمد الرواية الرسمية كثيرًا في الوعي الاجتماعي، فسرعان ما يسطر المجتمع تاريخه الموازي الجدير بالثقة.
يأتي الوجع حين يسأل الطفل أمه:
أين أبي يا أماه...؟ متى يرجع؟
وكالخنجر ينغرز السؤال في أعماق الأم وكل الأقرباء، وكانوا لزمن الغياب الطويل قد تحاشوا أن يهمسوا به سرًا لأنفسهم، لكن هنا لا مناص من الإجابة.
"أبوك سرح يقاتل العفريت، ماسك بيده شمعة، وبالثانية عطيف ابن علوان، لكن العفريت شم عرفه ولحقه وحبسه في غار تحرسه العنقاء المسحورة. لكن أبوك با يرجع لما يدري أنك مطيع وتعمل مثل الرجال".
تجد في أحشاء ملف "النداء" أشخاصًا وجهات على علاقة حميمة بالإخفاء، فضلت الصمت، نراها اليوم تجأر بالشكوى من ممارسة الإخفاء القسري بحق المحسوبين عليها... هي نفس المخرجات للمدخلات التي أُتخمت بها الحياة السياسية والاجتماعية منذ البداية، الحكاية هنا ليست خاصة، والرواية أكثر عمومية... لماذا يسأل البعض أنصاره وأتباعه فقط؟
مشين جدًا أن تتحول إنسانيتنا إلى عمل سياسي رخيص. ومشين كذلك الإصرار على تحويل الجاني إلى وسيط بين الضحية وذاته. دعونا نتساءل عن مصير كل المخفيين، كل مكلوم بالإخفاء، كل أسرة وامرأة وطفل جدير أن يعرف لماذا، متى وكيف، وأن يكون له تاريخ معلوم يمتد بين الولادة والممات.
الغريب في هذا الجانب أن الحكومة التي أنتجتها أحداث 2011، لم تنظر في الاتفاقية الدولية لعام 2006، إلا في 2013، ولم ينظر فيها البرلمان حينها، ولم تتخذ حكومة المناصفة أي إجراء حيال من تم إخفاؤهم خلال الفترة الماضية بين 1962 و2011، وبدلًا من ذلك شهدت البلاد عمليات إخفاء جديدة، ولا يبدو أنها ستتوقف.
في 2018 استعرض البرلمان في صنعاء "تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، وأكدت اللجنة أن "الحكومة قد وافقت عام 2013، على انضمام الجمهورية اليمنية لـ"(الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)"، ولأن الدنيا عوافي فقد اعتمدت اللجنة البرلمانية نفس توصيات الحكومة السابقة (بنت 2012)، والتي تقضي بالتحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) التي تنص على:
1. "أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف في ما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منهما أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة".
الملاحظ هنا أنه لم يبرز أي خلاف بين وجهتي نظر حكومة الأمس والبرلمان في صنعاء حول هذه الاتفاقية، يبدو أني أنا الوحيد فقط الذي لم يفهم سبب التحفظ على الفقرة المذكورة، وسبب عدم إقرار الاتفاقية حتى اليوم، وعدم توفر نوايا صادقة للإفصاح عن المخفيين السابقين أولًا من قبل الفاعلين أو المؤسسات التي أداروها، قبل أن يأتي الذي لا مرد له من الله.