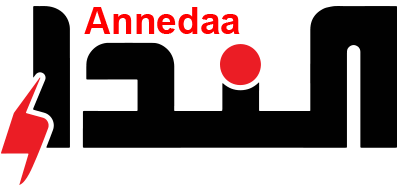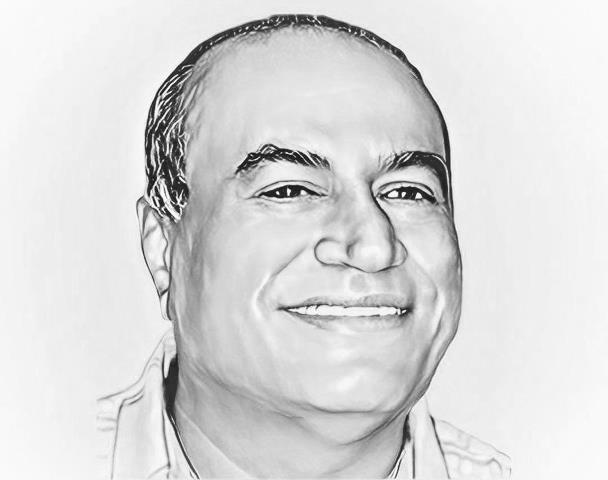بالأمس، وبينما كنت أعدّ ملخصًا بحثيًا حول واقع الأبحاث البينية في الجامعات العربية، والذي من المفترض أن يُعرض في مؤتمر علمي مرتقب بجامعة قطر، وجدت نفسي أتجوّل فكريًا في أقسام العلوم الإنسانية بمختلف الجامعات الخليجية. وخلال هذا التجوال الذهني، لفت انتباهي حضور كثيف ولافت للأكاديميين والباحثين القادمين من الدول المغاربية، تحديدًا من المغرب، الجزائر، تونس، وموريتانيا، مع نسبة أقل من ليبيا. تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 30% من الكادر الأكاديمي في هذه التخصصات ينحدر من هذه الدول، وهي نسبة لا يمكن تجاهلها.
وليس الأمر مقتصرًا على التوظيف الأكاديمي فقط، بل يمكن ملاحظة التفوق المغاربي أيضًا في ميدان الجوائز الثقافية والفكرية المرموقة التي تُمنح في دول الخليج العربي. فعلى سبيل المثال، نجد أن نسبة الفائزين من الدول المغاربية في جوائز كبرى مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجائزة العويس الثقافية، وجائزة الملك فيصل العالمية في السعودية، وجائزة كتارا للرواية العربية، وكذلك جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر، تصل إلى حوالي 50%. بل إن المغرب وحده يحافظ على حضور شبه دائم، حيث يحصد جائزة أو اثنتين في كل دورة من هذه الجوائز.
هذا الحضور لا يمكن تفسيره فقط بالرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية، رغم أن ذلك عامل مهم، إذ إن الباحثين من دول المشرق يعانون أوضاعًا معيشية أصعب، بسبب الصراعات والحروب وعدم الاستقرار الذي يعوق التطور الأكاديمي، ويشتت الجهود البحثية. لذا، فإن التفوق المغاربي يعكس في جوهره عوامل أعمق، أبرزها ثراء السير الذاتية للباحثين، وأصالة مشاريعهم، وجديّتها، وارتباطها باحتياجات وطموحات دول الخليج التي تسعى إلى بناء قاعدة معرفية حديثة.
كما لا يمكن إغفال أثر الاستقرار النسبي الذي تنعم به الدول المغاربية، مقارنة بنظيراتها في المشرق العربي، لا سيما بعد العام 2011 وما تبعه من أحداث ما يُعرف بالربيع العربي. فقد استطاعت هذه الدول، بدرجات متفاوتة، الحفاظ على منظومتها التعليمية والبحثية، وتطويرها بشكل لافت.
إضافة إلى ما سبق، ثمة عامل آخر بالغ الأهمية، يتمثل في حداثة المنهجية المعتمدة لدى الباحثين المغاربيين، والتي تعود جزئيًا إلى إجادتهم لعدة لغات أجنبية، بخاصة الفرنسية، الإسبانية، والإيطالية، نتيجة للإرث الاستعماري والقرب الجغرافي من أوروبا. هذه الميزات اللغوية فتحت لهم أبواب الاطلاع المباشر على المناهج الغربية الحديثة، والاستفادة من التطور الكبير في آليات البحث العلمي والتفكير النقدي.
ولعل خير مثال على هذا التميز، ما نلاحظه في تونس، ذلك البلد الصغير من حيث المساحة، الذي يُقدم، تقريبًا كل عقد من الزمن، مفكرًا أو فيلسوفًا يُحدث أثرًا لافتًا في الحقل الفكري العربي.
إن ما نشهده اليوم من توهّج مغاربي يقابله، للأسف، انطفاء مشرقي في الحضور العلمي والثقافي العربي، وهي مفارقة تستحق التأمل والتحليل، وقد تكون بداية لنقاش أوسع حول العلاقة بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الثقافي، وتطور البحث العلمي.