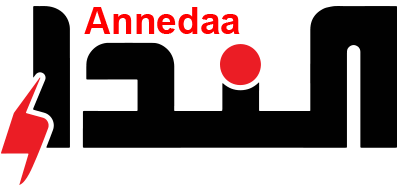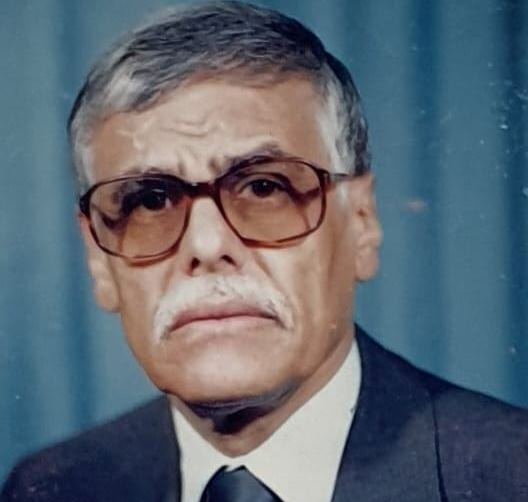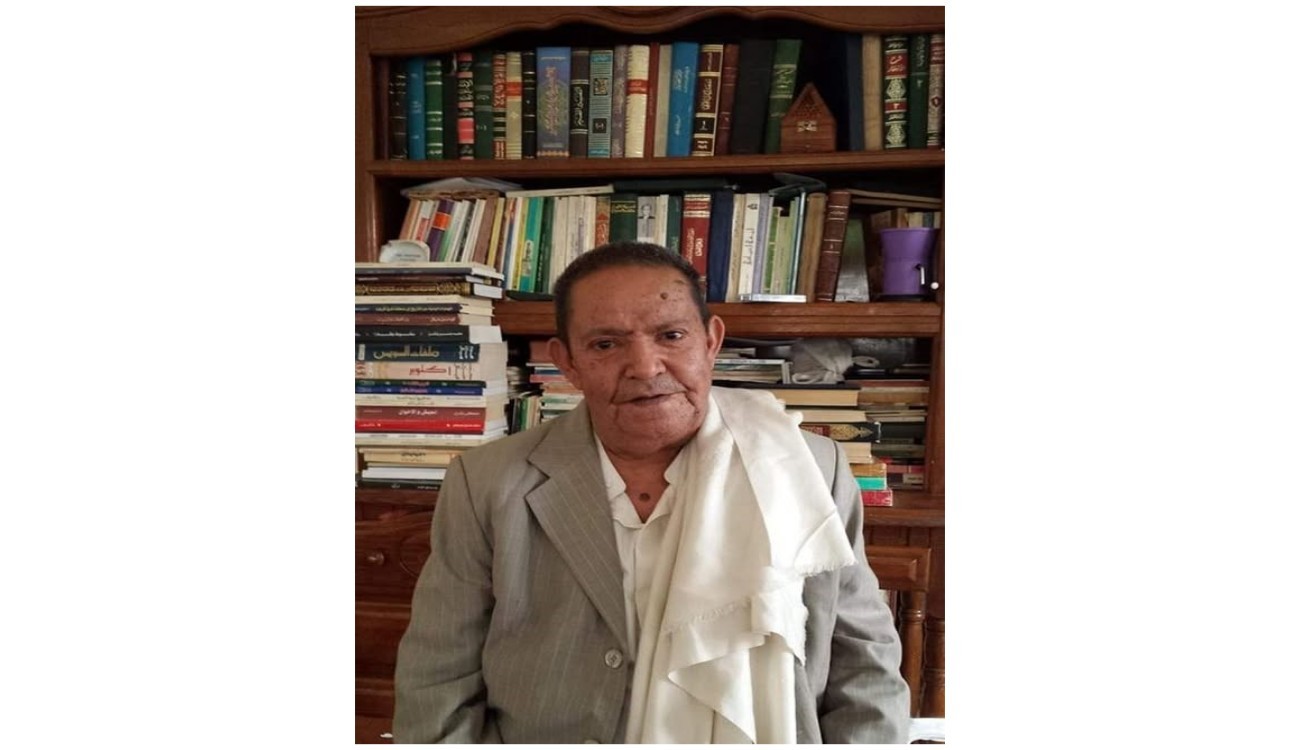انتقل إلى رحمة الله في القاهرة في ١٤ رمضان ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٥، الدكتور فضل أبو غانم، عضو مجلس الشورى، ووزير التربية الأسبق، وهو يتأهب للذهاب لأداء صلاة الجمعة.
عرفته عام ١٩٧٥ عن طريق نسيبي المرحوم د. محمد الحوثي، وهو قادم من ليبيا بعد مشاركته في مسيرة طلابية عربية من ليبيا حتى الحدود المصرية -الليبية، لتسليم سلطات الحدود المصرية وثيقة وقعت بالدم طالبت الرئيس السادات بالتوحد مع ليبيا، وقبل ذلك عرفت والده الودود علي أبو غانم.
درس الماجستير في فرنسا، وكانت أطروحته للدكتوراه في مصر عن "البنية القبلية في اليمن بين الاستمرارية والتغيير". العنوان يوحي بأنه كان من دعاة تغيير دور القبيلة ليتماهى مع التطورات التي حدثت بعد ثورة سبتمبر. كان المشرف اليمني على أطروحته هو الدكتور أبو بكر السقاف الذي أشاد عند عودته من القاهرة بجهده البحثي المتميز، واستحقاقه لدرجة الامتياز.
الأطروحة لاتزال المرجع الأم عن القبيلة لليمنيين و للكتاب العرب والأجانب، ومنهم د. بول دِرِش، مؤلف كتاب "الدولة والقبيلة في تاريخ اليمن الحديث"، الذي ترجمه إلى العربية د. علي محمد زيد، ووزعته دار أروقة للنشر في القاهرة.
لفتت أطر وحته انتباه شيخ من أراضي ١٩٣٤، أتى خصيصًا إلى صنعاء ليناقشه في معلومات رآها جديدة عن القبيلة في اليمن. أتذكر أن أحد الحضور سأله في المقيل بمنزل اللواء عبدالله أبو غانم، عن أية جنسية يفضل، وأن رده كان رجاء بلاش إحراج.
لسنوات عديدة خصص الفقيد وقته للعمل الأكاديمي في جامعة صنعاء، إدارة وتدريسًا، ولم يكن لديه طموح سياسي بأن يصبح وزيرًا، وقد فوجئ بتعيينه وزيرًا للتربية والتعليم، وهو في القاهرة.
سياسيًا اقتصر عمله على الوفاء بالتزاماته التنظيمية للتنظيم الوحدوي الناصري، الذي كان كغيره من الأحزاب يمارس واجباته الوطنية سرًا، وبعد التوزير كان لا يستطيع الفرار من العمل في إطار المؤتمر الشعبي العام كعضو في اللجنة العامة للمؤتمر التي ينضم إليها الوزراء تلقائيًا، وليس بالقناعة، بحكم مناصبهم، ويغادرونها بعدخروجهم من السلطة! تلك كانت هي القاعدة في ذلك التنظيم الفضفاص.
وزير التربية
لسنوات طويلة كانت الوزارة وزارتين؛ الأولى الحكومية العلنية، والثانية الإصلاحية/ السلفية غير العلنية. وكانت الغلبة، إدارة ومناهج، للأخيرة غير المهنية. حاول بعض أسلافه في الوزارة اختراق جدار التمذهب والازدواجية في التعليم، ولم يوفقوا. أما المعاهد الدينية فلم يقتربوا منها، لأنها كانت الكنز الاستراتيجي التعبوي والفكري والبشري لحزب الإصلاح، قبل أن يعلن عن نفسه كحزب بعد الوحدة التي ناصبها كما ناصب -كإخوان مسلمين- ثورة سبتمبر العداء.
عندما فكر د. فضل بإلغاء المعاهد لم تكن نواياه أيديولوجية، بل تربوية خالصة، لوضع التعليم في المسار الصحيح، وإنهاء ازدواجيته التي طالما نبه كثيرون الرئيس صالح لخطورتها على تماسك النسيج الاجتماعي والهُوية والولاء الوطنيين. مما مكنه من النجاح إعطاء الرئيس صالح الضوء الأخضر له لتنفيذ استراتيجيته، صيف عام ٢٠٠١.
كانت المعاهد تعليمًا موازيًا لا سلطة حتى للوزير عليه، وتمول جزئيًا من الخارج، ولا رقابة على إنفاقيها المحلي والخارجي، وبلغت ميزانيتها المحلية عند إغلاقها ثلاثة عشر مليار ريال، وكانت تساوي تمامًا ميزانيات المشايخ عام ٢٠١١.
كان للإلغاء تداعيات قوية، وبخاصة بين قطبي الإصلاح الشيخين الأحمر والزنداني اللذين لم يصدقا أن المطر سيأتي من الكنان الأرحبي.
بعد أشهر قليلة حدثت أحداث ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ الإرهابية، في أمريكا، وتم استهداف التعليم الديني المسيس، ومنه "المدرسة في باكستان" التي كان للزنداني دور في تأسيسها، وهو ما دفع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إلى التساؤل عن أسباب انحراف التعليم عن مقاصده التربوية.
كان الإلغاء خطوة استباقية تحسب للدكتور أبو غانم، لأنه جنّب اليمن ورعاة المعاهد أنفسهم متاعب لا مفر منها بعد أحداث ١١ سبتمبر، من قبل الولايات المتحدة واللوبيات الصهيونية وحلفائهما.
من جهة أخرى، مما يحسب للفقيد أنه عندما لاحظ من نافذة منزله الطلبة -الأطفال يحملون كراسيهم "السفري"، كل يوم، إلى مدرستهم التي لم يكن يوجد بها كراسي، آلى على نفسه ألا يجلس على كرسي مكتبه قبل حل المشكلة التي حلت بتمويل أمريكي بإعادة الحياة لمصنع أثاث مدرسي في عدن أهمل "لجنوبيته"! بعد حرب ١٩٩٤، وأمكن بعد ذلك تغطية نواقص التأثيث المدرسي في اليمن كلها، وهذا ما دفع جهة مستثمرة لعرض شرائه عليه، ولكنه لم يقبل رغم الإغراء.
للراحل إنجاز آخر هو تطوير المطابع المدرسية التي كانت تطبع بعض المناهج المدرسية، وبعضها الآخر يطبع في الخارج، وقد استثمر الوفر بالاعتناء بوضع المعلمين المالي، ونشر التعليم في عدد من المناطق المحرومة.
ومن إنجازاته تسهيل التحاق طلاب المناطق النائية بالجامعة بمجموع أقل، وهذا أدى إلى تأهيل المئات من الخريجين في مهن عديدة، خدموا في مناطقهم بعد تخرجهم، وأسهموا في تنميتها.
بعد عاصفة الحزم عام ٢٠١٥، والتدهور الكلي لأوضاع البلاد، وتفكيك سلطتها المركزية، آثر الفقيد العيش في القاهرة التي تحتضن ما يزيد عن مليون يمني، عُشريهم على الأقل من النخب التي شلّت الحرب وتوابعها قدراتهم في خدمة وطنهم، وكان حضورهم، ومنهم الشباب، في صالة عزاء الفقيد، في ١٧ مارس، مذكرًا مؤلمًا بهذه الخسارة الوطنية الكبيرة.
كان الفقيد من دعاة المصالحة الوطنية كوسيلة وحيدة لتطبيع الأحوال في البلاد، وتفادي خسائر وطنية أهم وأكبر.