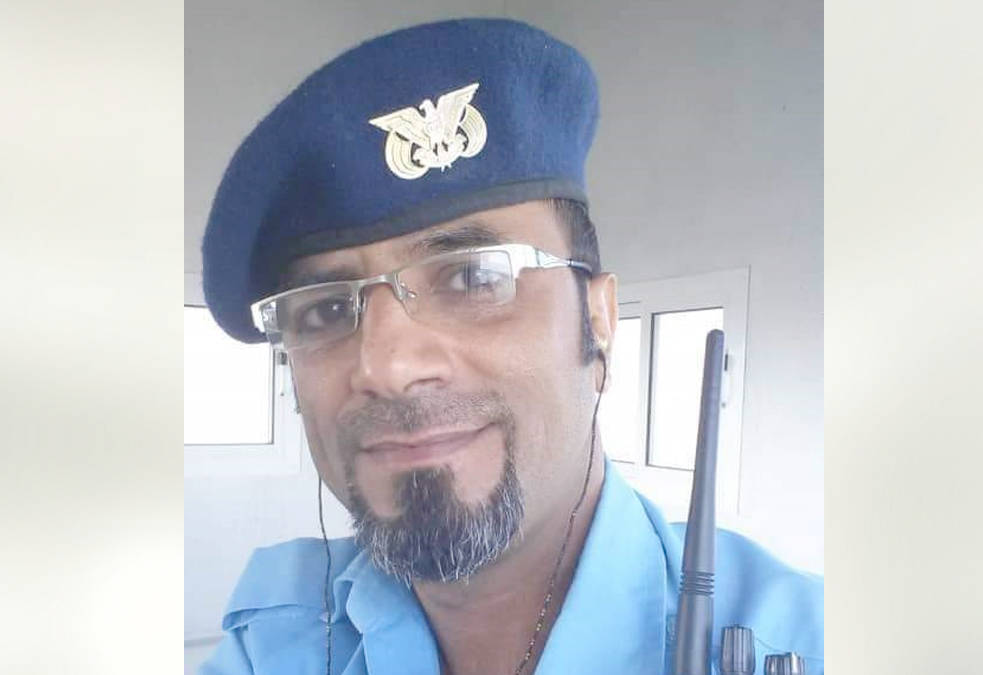ماذا عن مصالحة وطنية لا تنتصر للأقوياء وحدهم..؟
وضاح المقطري
يبقى دائماً في خروج بلد ما من الحرب ما يعني بالضرورة احتمال دخوله في حرب أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب السابقة؛ ما لم يتم بتر أسباب هذه الحروب وتحقيق سلام قائم. على ثقة تامة بنتائج الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تم بها إنهاء الصراعات، بتحديد أسبابها وإيجاد بدائلها المنصفة للفئات والطوائف المختلفة داخل المجتمعات المحلية كخطة مثلى لتحقيق العدالة الانتقالية؛ ذلك أن هذه العدالة لا يمكن تحققها بغير إنهاء أسباب الحروب المرتكزة بشكل أساسي في الظلم الاجتماعي الناتج عن سوء التوزيع، واستغلال الموارد الاقتصادية، والهبات الدولية لصالح الجهات والعشائر التي تحسب رموز الانظمة السياسية عليها.
في الندوة الإقليمية عن العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي التي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، قُدم الكثير من الأوراق التي تحدثت في مجملها عن العدالة الانتقالية، وإجراءات تنفيذها، وطرق تحقيقها من جوانب حقوقية بحتة، ولم يتم الحديث عن إصلاحات سياسية وديمقراطية واجتماعية لتحقيق هذه العدالة سوى في لمحات ولقطات متفرقة منها ما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا، وأهمها وأوضحها ما قدمه الأخ سامي غالب في مداخلته من أن تاريخ اليمن تاريخ جماعات وليس تاريخ وطن، وهو زاخر بالمصالحات التي تتم بين هذه الجماعات التي يحتكر زعماؤها تمثيلها، فتقوم المصالحات على أسس غير حقوقية تنتقص حقوق الأفراد داخل هذه الجماعات، ما يعني أن مثل هذه المصالحات لا تحقق عدالة من أي نوع، لأنها لا تؤدي إلى التطهر من حمولة ماضي القمع والإلغاء.
قد ينطبق ما قاله سامي غالب على وضع المصالحة الحادثة الآن في صعدة بعد أربع سنوات من حرب لم يكن لها معنى واضح أو محدد، وانتهت مؤخراً باتفاق لم تتضح بنوده الحقيقية بعد، وإن كان على ما يبدو لا يحفظ للضحايا المدنيين قتلى وجرحى ومشردين حقوقهم أو يعيد لهم الاعتبار.
يتطلب الأمر دائماً إعادة البناء الاجتماعي، وتحقيق العدالة التوزيعية في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وصناعة وعي شامل بحقوق الإنسان والمواطنة والحريات وحركة تنقلات الأفراد والجماعات وحرياتهم الشخصية والجمعية وقناعاتهم الفكرية، ومساهمة كافة الفئات والطوائف والأجيال والأنواع في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وحينها فقط يمكن الحديث عن قيام ثقافة سلام بديلة لثقافة الحرب.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إلغاء الانقسامات الداخلية، وإيجاد وحدة حقيقية من خلال مشاريع التنمية ونشر ثقافة و طنية وعلمانية تتجاوز الانتماءات القبلية والدينية أو تلغيها، ما يؤدي بالضرورة إلى إصلاحات قضائية وقانونية تكفل تحقيق المواطنية الخالية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو ا لطائفة أو الدين، وأضع خطاً تحت كلمة «الدين» هنا، كي نتذكر أنه تم ويتم إلغاء الحزن الإنساني فيه، واستخدامه في حروب الإبادة؛ لأن كل طائفة ترى أحقيتها المطلقة في احتكار الحقيقة في وجود دافع اقتصادي غالباً ما يدفعهما بالتالي إلى إلغاء الآخر وحقه في التفكير والوجود.
وعن أطر تحقيق عدالة انتقالية، فإنه ينبغي الانتباه إلى أنه لا بد من معادلة إنصاف تراعي خصوصية كل مجتمع على حدة، من أجل إيجاد تكافؤ بين طريقتي العدالة الانتقالية، وهما المعاقبة القانونية والمصالحة، حيث ان معالجة آثار الحروب في نفسيات الأفراد والمجتمعات المتخلفة قد لا تكون ممكن بالمصالحة وحدها، نتيجة للعديد من الموروثات القبلية والدينية، وتعقد البنيات الاجتماعية والنفسية في المجتمعات المحلية، وبالتالي لا بد من العمل بطريقتي العدالة مجتمعتين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير كافة الإمكانات التي تحقق الأمان المستقبلي للجناة الراغبين في الإعتراف بخطاياهم من ثارات أو عمليات انتقام قد تحدث لهم من قبل ضحايا مفترضين. وفي رأيي الشخصي أن جيلين على الأقل يتأثران بالحروب ومآسيها، أحدهما هو الذي شهد المآسي بنفسه وعايشها عن قرب، وتأثر بها بعمق، ولهذا فمن الصعوبة إقناعه بمسألة العدالة دون أن يشهد بنفسه عقاباً قانونياً للجناة. فيم يكون الجيل الآخر غير شاهد على مآسي الحرب مباشرة، وإنما جاء على إثرها وطالته آثارها، ما يجعل من الممكن جداً إقناعه بالمصالحة وخلق روح التسامح لديه بواسطة الإجراءات الممكنة على المستويين الحقوقي والاجتماعي السياسي.
ولأنه معلوم أن المجتمعات النامية ما زالت تعطي الدين مساحة واسعة لتحديد قراراتها المصيرية، وبالتالي فإن ثقافة التسامح في المجتمعات الطائفية تواجه بصعوبات بالغة تتمثل في عدم القبول بالتسامح والتصالح مع الطوائف الأخرى، ويتم الاحتكام فيها إلى شرائع تُطبق أحكاماً قضائية غير إنسانية أو عصرية، تتمثل في العقوبات البدنية التي أبرزها الإعدام، كما يحدث في القضاء الإسلامي مثلاً.
إلى ذلك ينبغي أيضاً السرعة في تأهيل مشاريع العدالة الانتقالية سواءً القائمة على المعاقبة القانونية، أو المصالحات وجبر الضرر بالتعويضات المادية والمعنوية، فكلما تأخرت العدالة في الحضور كان حضورها أصعب، إذ تتعمق الآثار النفسية، وربما تمكن الجناة من الهرب، أو قد يموت الشهود أو الضحايا أو الجناة، وفي تأخر تحقيق العدالة تهيئة لصراعات جديدة.
إن استمرار الأنظمة العسكرية والقبلية السياسية الحاكمة المتسببة أصلاً في النزاعات، والمساهمة في حروب الإبادة، يعطل إمكانية تحقيق عدالة انتقالية إلا على هيئة مكرمات تقدمها هذه الأنظمة للشعوب والجماعات، أو بطريقة مصالحات بين الزعماء، على الطريقة التي ذكرها الأخ سامي غالب، تلغي دور الأفراد وتنتقص حقوقهم. وعليه لا بد من الضغط على هذه الأنظمة وإجبارها -بشتى السبل- على القبول بديمقراطية حقيقية تحترم اختيارات الشعوب.
يبقى القول إنه يصعب علينا التفاؤل بإمكانية مصالحة وطنية حقيقية في اليمن، تلغي كل أحقاد وصراعات الماضي، وتعيد عتبار للضحايا، وتكفل حقوقهم، وتعطي للجناة فرصة الاعتراف بخطاياهم والاعتذار عنها، والاندماج في المجتمع دون خوف من نار أو قصاص، فالسلطة دأبت على فتح ملفات منتقاة من الماضي للتشهير بخصومها، أو تأجيج الكراهية، متغافلة عن ملفات كثيرة، وقضايا لا تحصى، ومستمرة في سياسات تنتهك الحقوق في كل مكان كأنها تحرص الناس ضدها، غير عابئة بمطالب شعبية تنشد مصالحة وطنية لا تنتصر للأقوياء وحدهم.
***
ندوة العدالة الإنتقالية وانتهاء حرب صعدة
2007-06-27